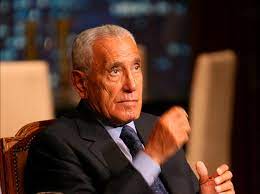القيادة الفلسطينية.. من الرمز إلى التاجر

كتب عبدالكريم سليمان العرجان في صحيفة العرب.
القيادة الفلسطينية من منظمة التحرير إلى السلطة لم تنزلق فجأة إلى منطق “التاجر” بل كانت تنحدر نحوه منذ اللحظة التي وقّعت فيها على وثيقة أوسلو لا كمناورة بل كخيار وجودي.
بمقال موجع بعنوان “فلسطين في دكانة السياسة: اعترافات بلا سيادة”، وضعت الكاتبة ربى عياش إصبعها على جرح رمزيّ عميق، كيف تحوّلت القضية الفلسطينية إلى مجرّد واجهة سياسية في سوق الاعترافات الدولية، بلا أدوات قوة، وبلا مشروع تحرّر فعلي. ومن هذه الفكرة تحديداً ينطلق هذا المقال، لا ليكتفي بتوصيف المشهد، بل ليستكمل المسار ويطرح السؤال الأخطر:
كيف تحوّلت القيادة الفلسطينية نفسها من رمز نضالي إلى تاجر سياسي؟ وكيف انخرطت كل النخب، بما فيها حماس، في دورة إعادة تدوير الهزيمة، وتبادل أدوار تحت عباءة المقاومة أو التسوية، بينما القضية تذوب بين خطابات البطولة وموازنات البقاء؟
لم تكن النكبة فقط لحظة ضياع أرض، بل لحظة ميلاد رمز. الفلسطيني خرج من الجغرافيا ودخل الأسطورة، صورة اللاجئ، الفدائي، المفتاح، الكوفية.. كل هذا جعل القضية أكبر من واقعها، وأقرب إلى أيقونة أممية. لكن ماذا يحدث حين تُسلّم هذه الأيقونة إلى من يُتقن إدارة الملفات أكثر من إدارة المعارك؟ ماذا يحدث حين تُختصر الثورة في موازنة وزارة شؤون مدنية، ويصبح النضال وظيفة بدوام جزئي على طاولة التنسيق الأمني؟
الحقيقة الجارحة أن القيادة الفلسطينية، من منظمة التحرير إلى السلطة، لم تنزلق فجأة إلى منطق “التاجر”، بل كانت تنحدر نحوه منذ اللحظة التي وقّعت فيها على وثيقة أوسلو، لا كمناورة، بل كخيار وجودي. من هناك بدأ التحوّل: من رمز نضالي يُلهم الشعوب، إلى تاجر سياسي يُقايض الدم بالتصريحات، والمقاومة بالمنح المشروطة.
في عالم ما بعد أوسلو، لم تعد فلسطين تُحرّر، بل تُدار. لم تعد القيادة تقود مشروعاً للتحرر، بل تُشرف على “عملية سلام” دائمة العجز، تُموّلها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتناوب على إدارتها موظفون يحملون لقب “قيادات وطنية”.
في عالم ما بعد أوسلو، لم تعد فلسطين تُحرّر، بل تُدار. لم تعد القيادة تقود مشروعاً للتحرر، بل تُشرف على “عملية سلام” دائمة العجز، تُموّلها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويتناوب على إدارتها موظفون يحملون لقب “قيادات وطنية”
ومع الوقت، تحوّل الفعل السياسي الفلسطيني إلى دبلوماسية استجداء، تتوسل اعترافاً رمزياً من دولة هنا، وتصويتاً أمميًا هناك، ثم تعود لتحتفل بنصر معنوي لا يغيّر شيئاً في واقع الاحتلال. رمزية بلا أدوات، دولة بلا دولة، سيادة على الورق فقط. هذه ليست دولة، بل متجر سيادة تُباع فيه الشعارات على رفوف الشرعية الدولية.
في مشهد عبثي، باتت القيادة الفلسطينية تحتفل بالاعترافات أكثر ممّا تُقاوم الاحتلال. صار إعلان دولة فلسطين في الأمم المتحدة أهم من وجودها على الأرض. أما الشعب الفلسطيني، فقد تحوّل إلى أداة رمزية في هذه السوق، يُستَشهد ليُقال للعالم “انظروا إلى فداحة الاحتلال”، ثم يُنسى في مخيماته.
الخطير هنا ليس الفساد ولا العجز فقط، بل انهيار السردية ذاتها. فحين تتحوّل القضية من مشروع تحرّر إلى مشروع تمويل، ومن قيادة مستعدة للتضحية إلى نخبة تبحث عن “التمكين الاقتصادي”، تصبح القضية دكانة، تماماً كما وصفتها ربى عياش بمرارة في مقالها المشار إليه.
وإن كانت منظمة التحرير قد انتقلت من البندقية إلى “بطاقة الائتمان السياسية”، فإن حماس لم تكن استثناءً، بل نسخة جديدة من اللعبة القديمة، وإن اختلفت الشعارات. فالحركة التي دخلت غزة على أكتاف المقاومة، باتت اليوم تُدير ما يشبه سلطة ظلّ، وتعيد إنتاج المنطق نفسه: سلطة بلا سيادة، ومعابر تحت رحمة الاحتلال، ومفاوضات غير مباشرة أكثر من أن تُحصى.
وما بين “التمكين” و”التهدئة”، وجدت حماس نفسها تُدير واقعاً يفرض التعايش مع الاحتلال أكثر ممّا يهدد بزواله، تماماً كما حدث مع فتح حين استقرّت في رام الله بعد أوسلو. تتغيّر الأسماء، لكن يبدو أن كل من يقترب من إدارة الجغرافيا، يبتعد عن تحريرها.
المعضلة ليست في الفصيل، بل في المنظومة التي تبتلع الجميع حين يُستبدل المشروع التحرري بمشروع الحكم.
أمام هذا الانحدار الجماعي، تبدو الحاجة اليوم ليست إلى فصيل جديد، بل إلى نمط جديد من القيادة، يعيد تعريف النضال لا بوصفه وظيفة أو تمثيلاً دبلوماسياً، بل باعتباره مشروعاً للتحرر الكامل. فالقضية الفلسطينية لم تُهزم فقط بالمدافع، بل بالتدريج الإداري، والتطبيع الرمزي، وبتحوّل القيادة من رمز إلى تاجر.
وإذا كان العدو واضحاً في صهيونيته، فإن الأخطر هو الصديق الذي يحوّل الثورة إلى مصلحة، ويبيع الوطن باسم القضية، ثم يطالبك بالتصفيق تحت الاحتلال.
فلسطين لا تحتاج تاجراً آخر.. بل قيادة تهدم المتجر، وتعيد فتح دفتر التحرير.