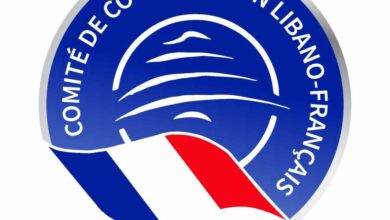كتب أمين الزاوي في “إندبندنت عربية” : حين يصبح الدين كرة ثانية في الملعب، كرة أيديولوجية تكبر ككرة الثلج على الأفواه وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حين يصبح الدين ككرة بين أرجل اللاعبين التي تتسابق على المنافسة تحت مظلة شركات رأسمالية متوحشة تأكل ما في الجيوب من أخضر ويابس، أو يصبح حساباً بنكياً لذوي القرار في “فيفا” وغيرها. ثق أنه حينها يصبح الإنسان المحب لكرة القدم، مؤمناً كان أم غير مؤمن معرضاً لكل انتهاك في أبعاده الروحية والأخلاقية والعقلية؟
ونحن نتابع، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قنوات بعض التلفزيونات الكبرى، كيف أصبح الدين جزءاً من لعبة كرة القدم، بل أصبح لعبة داخل لعبة، لعبة أيديولوجية داخل لعبة اقتصادية تحت شعارات رياضية، هذه الحال تجعلنا نتساءل إلى أي مدى اختلطت الأمور ولم يعد هناك رادع أخلاقي للاستثمار في كل شيء من أجل الترويج لأيديولوجيا معينة؟
كنا نقول إن كرة القدم أصبحت ديناً عالمياً جديداً، وكنا نقول أيضا ولا نزال، كرة القدم أفيون الشعوب، وهذا صحيح جداً، لكن ما لم نقله هو أن هذا الدين الجديد الذي هو الابن الشرعي لأكبر الرأسماليات العالمية العابرة للقارات، أضحى يحرك الدين السماوي ويتقاذفه كما يتقاذف اللاعبون الكرة الجلدية.
آلاف الملايين، بل مليارات من البشر الذين يتابعون كرة القدم ما هم إلا عبارة عن سجل تجاري مهم للاستهلاك في عيون الشركات المتخصصة في الألبسة والمشروبات الكحولية وغير الكحولية والهواتف والفنادق والمطاعم وشركات النقل وشركات الـتأمين واستوديوهات الموسيقى ومخابر التجميل والبنوك. إنها شركات تصرف ملايين الدولارات في إشهارها الذي يرافق دورات كأس العالم ومن خلال ذلك تجني أضعافاً مضاعفة.
وإذا كانت الفلسفة الأصلية والأولى التي قامت عليها كرة القدم اللعبة الشعبية الأكثر جماهيرية هي الدفاع عن التعايش في سلم والتشارك في الأفراح ومقاسمة اللعب بكل أبعاده الطفولية الجميلة، أو هكذا من المفترض أن تكون، إلا أن كرة القدم خرجت عن عقلها وجرّاها قامت كثير من النزاعات بين الأمم، ومنها ارتوت ثقافة العنف والتشدد وعلى مدرجاتها استعادت الأيديولوجيا الوطنية الشوفينية مجدها من دون رقيب.
وقد قدمت السينما العالمية مئات الأفلام الخالدة عن كرة القدم من وجهات نظر سياسية أو اجتماعية أو أوتوبيوغرافية، وعرف الأدب السردي كذلك بعض نصوص روائية محدودة عربياً وعالمياً، على سبيل المثال لا الحصر، رواية “الفائز بالكأس” Le vainqueur de coupe لرشيد بوجدرة التي ترجمت إلى العربية تحت عنوان “ضربة جزاء” أو رواية “باغاندا” لشكري المبخوت أو رواية “يوم بيليه ذاك” Le jour où Pelé لعبدالقادر جمعي وغيرهم.
لكن الرابح الأكبر من كرة القدم هي تلك الأحزاب السياسية التي ظلت عينها مفتوحة على جماهير كرة القدم، تراودها وتحاصرها، حتى أصبحت حناجر آلاف المشجعين في المدرجات شعارات أحزاب من اليمين أو من اليسار أو من الإسلاميين.
خرجت كرة القدم عن هدفها الذي هو “اللعب” و”المنافسة الشريفة” إلى سوق السياسة وسوق المال والأعمال.
وهناك كثير من الثورات والانتفاضات في العالم العربي والإسلامي خرجت من الملاعب، أو تم شحذها على هذه المدرجات من خلال شعارات مدروسة مسبقاً.
وعلى المستوى الفني برز تيار غنائي شعبي متميز، في الكلمات والألحان، بالعالم العربي والإسلامي قائم على فكرة المعارضة الاجتماعية والسياسية والنقابية والتعبير عمّا يعانيه المواطن البسيط من القهر والظلم والتمييز الاجتماعي، وقد عرفت بعض الأغاني شهرة واسعة ظلت تهدد أركان الأنظمة المستبدة.
بعد أن استحوذت أيديولوجيا الأحزاب الإسلامية، في العالم العربي والإسلامي، على جماهير المؤمنين في المساجد، حيث استعملت التجمعات خمس مرات في اليوم، تجمعات الصلاة، كمنجم للدعاية السياسية، والبروباغندا، زحفت على ملاعب كرة القدم الشعبية لتحول مدرجاتها إلى منصات ومصانع لصناعة الأتباع وتوسيع الوعاء الانتخابي.
إن الأحزاب السياسية الإسلامية أكثر القوى السياسية في العالم العربي وشمال أفريقيا التي تفطنت لدور مدرجات كرة القدم في توسيع قاعدتها السياسية والأيديولوجية، ولأن سيكولوجيا جماهير كرة القدم تتميز بالعنف فإنها قريبة من أيديولوجيا الأحزاب الدينية المتطرفة القائمة هي الأخرى على ثقافة الغضب والتشدد ورفض الآخر وإلغاء كل موجود والبدء من الصفر، لذا فإننا نشعر بأن هناك تجاوباً سيكولوجياً كبيراً ما بين تركيبة جماهير كرة القدم وتركيبة نظائرهم من الأحزاب السياسية الإسلامية المتطرفة بالعالم العربي والإسلامي، والحال نفسها نجدها أيضاً في أوروبا وأميركا بين جماهير كرة القدم وأتباع التيارات السياسية المتطرفة والنازية الجديدة.
واليوم ومع تنظيم دولة قطر لدورة كأس العالم 2022 بالدوحة، وهي أول دولة عربية وشرق أوسطية تنظم مثل هذا الحدث العالمي الكبير، وهذا فخر ومكسب للمنطقة برمتها، إلا أنه وبدلاً من الحديث عن مستوى كرة القدم في بلدان العالم العربي وشمال أفريقيا، وعن تأخرنا في اللحاق بشعوب فقيرة أو غنية منحت هذه اللعبة أهمية كبيرة، وبدلاً من العمل على تقديم صورة عن المواطن العربي وعن ثقافته وأحلامه والمشاريع التي يمكننا تحقيقها بإعادة الثقة بين الأنظمة العربية ونظرائها بالعالم، أغرقنا العالم في خطاب عن الدين، وكأن الإسلام في خطر، وكأننا نريد أن نبرر للعالم بأننا مسلمون.
لقد تم تجييش كثير من الدعاة لهذه المناسبة الرياضية العالمية والإنسانية والابتهاجية، وكأننا قادمون على خوض حرب داحس والغبراء، أو على غزوة بدر أو غزوة أحد جديدة، سيوف الأيديولوجيا مسنونة على كل المنصات وكأنما المسلمون جميعاً وهم ينظمون هذه الدورة مجندون في حرب أيديولوجية وليسوا في لعبة كرة تقدم فيها المتعة والجمال والتنافس البديع والاحتفال بالآخر المختلف عنا.
وبدا المسلم، كما تقول بعض منصات التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية على ألسنة بعض الدعاة، سعيداً وهو يقرأ أخباراً خادعة ومفبركة أو للاستهلاك عن عدد “رؤوس” الأجانب الذين يدخلون الإسلام يومياً فرادى وجماعات، وكأننا في السنوات الأولى لنزول الوحي.
إننا ونحن نسمع الخطابات الأيديولوجية ونقرأ ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالخطابات الدعوية نعتقد بأننا على ظهور خيول وأفيال خارجة للتو من رمال صحاري الجزيرة العربية ومتجهة جهة الغرب لبدء معركة الفتوحات الجديدة الحاسمة.
ماذا كان سيكون رد المسلم لو أن، مثلاً، حدث وأن دولة من الدول المسيحية الأوروبية أو الأميركية أو الهندوسية أو اليهودية التي سبق لها ونظمت دورة الكأس، دعت إلى المدرجات رجال الدين المسيحيين أو الهندوسيين أو عبدة البقر أو اليهود للتبشير في أوساط العامة من عشاق كرة القدم؟ ماذا كان سيكون رد المسلم يا ترى؟ سيكون الرفض والغضب وسيكون على حق في ذلك.
صحيح، إن كثيراً من الأصوات في الغرب، تحركها ثقافة المركزية الأوروبية المريضة والعنصرية، كانت ضد تنظيم هذه الدورة في هذا البلد العربي الشرق-أوسطي، لكنهم وجدوا لأصواتهم هذه صدى من خلال تصرفات بعض المسلمين وهم يبحثون عن أسلمة كل شيء من الاحتفال بكرة القدم العالمية إلى الإشارات التي تنظم حركة السير في الطرقات العامة