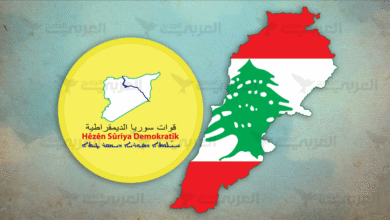من دروس الثورات العربية… الثورة السورية خصوصاً

كتب برهان غليون, في “العربي الجديد” :
عندما اندلعت الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، وصار واضحاً أن دائرة الاحتجاجات التي ميّزت جميع ثورات الربيع العربي أخذت تتوسّع ويزداد المحتشدون تصميماً على المواجهة، بالرغم من العنف المفرط الذي تعرّضت له، كان أول ما خطر في ذهني وسجلته في مقالة بعنوان “المعجزة السورية” أن الثورة السورية انتصرت. ويعني الانتصار هنا أن النظام لم ينجح، بالرغم من امتلاكه آلةً قمع قوية وتهديده المحتجين بالرصاص الحي، في منع الجمهور من تحدّي إرادته والتغلب على خوفه والنزول إلى الشوارع، فالثورة تعدّ ناجحة في اللحظة التي يكسر فيها الجمهور جدار الخوف، ويعلن نهاية عهد القهر والاضطهاد. تماماً كما تخسر الأنظمة رهانها منذ اللحظة التي يصبح فيها العنف غير قادرٍ على ردع الجمهور وإجباره على الاستمرار في الخضوع والطاعة، وبالتالي استحالة عودة الأمور إلى الوراء ثانية. وهذا ما حصل لجميع ثورات الربيع العربي التي شهدت رحيل رؤساء وإسقاط النظام الفردي. لكن إسقاط النظام لا يعني تلقائيا قيام نظام جديد، ولا يوجد مثل هذا النظام جاهزاً لا في عقل الجمهور ولا في شروط الواقع. هذه معركة أخرى تحتاج إلى قوى سياسية وشروط اجتماعية وجيوسياسية مختلفة.
بهذا المعنى، لا يختلف مسار الثورة السورية كثيراً عن مسار الثورات العربية الأخرى، مع فارق واحد، لكنه كبير، وكانت له نتائج خطيرة بشكل مأساوي، أن تدخّل القوى الإقليمية والدولية لم يأت بعد سقوط النظام للحيلولة دون قيام نظم ديمقراطية تخضع لإرادة الشعب والناس، وإنما جاء منذ بداية الثورة، ومع خطط جاهزة لإجهاضها والقتال إلى جانب النظام لدحر القوى الشعبية وتدميرها بأي ثمن. وفي هذه الحالة، لم يكن من الطبيعي والمنتظر أن يعرقل التدخّل الأجنبي تقدّم الثوار أو يقتصر أثره على القضاء على القوى القيادية في الثورة فحسب، وإنما مكّن النظام القائم من استهداف الحاضنة الشعبية ذاتها.
هذا ما حصل جزئياً في ليبيا، وبشكلٍ كبير وشامل في سورية. وهو الذي يفسّر الطابع الاستثنائي لمسار ثورة السوريين في السنوات الثلاث عشرة الماضية، حيث تحوّلت الثورة المضادّة المدعومة بالقوى الخارجية، وفي مقدّمها مليشيات طهران العراقية واللبنانية والأفغانية والباكستانية الطائفية، إلى حرب إبادة جماعية حطّمت المجتمع وشرّدت نصف الشعب، ودمّرت الاقتصاد والمرافق العامة، تماماً كما يحصل في غزّة اليوم، وقسّمت البلاد إلى إمارات حرب تسيطر عليها المليشيات التي تعمل تحت إشراف الدول الأجنبية ولحسابها، وتضمن لها سيطرتها ومناطق نفوذها.
في عالم أصبح شديد الترابط والتداخل في المصالح والمصائر، من المستحيل ألا تثير ثورة أي شعب، مهما كان ضعيفاً وهامشياً، شهيّة الدول الإقليمية الأكبر
لا يرجع هذا الإخفاق في تحقيق التغيير في البلدان العربية التي شهدت ثوراتٍ شعبيةً عفوية مماثلة إلى ضعف القوى الثورية وضمور التنظيمات السياسية والمدنية، وهما اللذان لا يشكلان الإرث الطبيعي للنظام الاستبدادي وتأبيد قانون الأحكام العرفية فحسب، ولا إلى الأخطاء التي وقعت فيها الأطراف الاجتماعية المختلفة التي شاركت في إطلاق الثورة وقيادتها فقط، وإنما يرجع أيضاً إلى التدخّل الواسع السرّي والعلني للقوى الخارجية، العربية والدولية، كما حصل في مصر وتونس واليمن والبحرين وسورية بشكل واضح وشامل. والواقع أن هذا التدخّل يكاد يكون أحد القوانين التي تحكم جميع الثورات التي حصلت في القرنين الماضيين، فالتغيير في نظم الحكم في هذا البلد أو ذاك لا يمسّ التوازنات الاجتماعية والسياسية الداخلية فحسب، ولكنه يهدّد بتغيير التوازنات الإقليمية، وربما، في منطقة حسّاسة جيوسياسيا، يؤثر على المعادلات الدولية القائمة أيضا.
يقودني هذا إلى التذكير ببعض ما يمكن أن نسميه دروس الثورات الشعبية الراهنة ومآلاتها في البلاد العربية، كما هو الحال في أكثر البلدان، والتي يمكن أن نستفيد منها في توجيه المرحلة المقبلة التي ستشهد بالتأكيد والضرورة عودة الاضطرابات والصراع العنيف لاستكمال ما لم يكن بالإمكان تحقيقه.
الأول أنه لا توجد ثورة على نظم قهرية تنعدم فيها كل أشكال الحرية الفكرية والسياسية، ولا تستمر إلا بفرض قانون الطوارئ، تمتلك سلفا عوامل انتصارها من وعي بالمشكلات والتحدّيات وتنظيمات سياسية فاعلة، فهي تتّخذ، في هذه الحالة، شكل انفجار عفوي وردّ فعل على شروط حياة وضغوط داخلية وخارجية لم يعد من الممكن احتمالها، وهي تنتظر الفرصة السانحة وأي اختلال في توازن النظام القائم. وهي تجري في مجتمعاتٍ حرم عليها النقاش والحوار والنشاط السياسي، وبالتالي لم تملك شروط بناء التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية التي تمكّنها من التنسيق بين نشاطاتها وبلورة خطط واحدة ومنسجمة والعمل حسب رؤية مشتركة وناجعة. وحتى لو نجحت في القضاء على نظام قائم فقد شرعيته وقدرته على الردع في مواجهة ملايين البشر الغاضبين، فهي غير قادرة بجرّة قلم على وضع أسس نظام جديد يستجيب لتطلّعاتها. فليس من السهل، بل إن من المستحيل على الجمهور الثائر الذي توحّده إرادةٌ مشتركةٌ بسيطةٌ لتغيير النظام أن يكتشف أو يطوّر بسرعةٍ عهداً اجتماعياً ورؤية مشتركة للمستقبل، بل حتى خطة واستراتيجية واحدة لمواجهة القوى المضادّة، فهذه الثورات العفوية لا تملك قيادة سياسية حقيقية، ولا خططا واضحة للثورة، ولا يمكنها المراهنة على نخبٍ تفتقر هي نفسها للرؤية الواحدة والتنظيم والخبرة السياسية، بل تكاد تكون غير موجودة أو عديمة الوزن وشديدة الانقسام، بعكس ما عرفته الثورات السياسية والاجتماعية التي سادت في بدايات القرن الماضي باسم التحرّر الوطني أو الوحدة القومية أو الثورة الاشتراكية والشيوعية، والتي قادتها نخبٌ سياسيةٌ ومثقفةٌ تمرّست بالنضال، وخاضت فيما بينها معارك فكرية وبلورت وعياً مشتركاً وأيديولوجياتٍ جامعة، وطوّرت خططاً واستراتيجياتٍ عقلانية واضحة ومسبقة لمواجهة القوى المحليّة والأجنبية.
قرّر الروس منذ البداية أخذ سورية رهينة يستخدمونها في نزاعاتهم الدولية، ويقدّمونها طُعما للدول التي تسعى إلى النفوذ في تعزيز علاقاتهم الإقليمية
والدرس الثاني المهم أنه في عالم أصبح شديد الترابط والتداخل في المصالح والمصائر، من المستحيل ألا تثير ثورة أي شعب، مهما كان ضعيفاً وهامشياً، شهية الدول الإقليمية الأكبر، بل والقوى الكبرى ذاتها لاستغلالها، سواء بالاستثمار فيها لتحقيق مصالح خاصة بها، من زيادة نفوذ، أو بتحطيمها لتقويض نفوذ (ومصالح) الدول الاخرى التي يمكن أن تستفيد من انتصارها، وذلك بصرف النظر عن مصالح أصحاب الثورة وتضحياتهم. ولا شك أنه كان لطموح النظام الإيراني الذي لا تخفيه طهران إلى بسط سيطرتها على سورية والعراق ولبنان، في مواجهة ما تعتبره التكتل العربي المعادي لها في الجزيرة والخليج (الحليف لعدوها الأول الولايات المتحدة)، الدور الأكبر في الإبقاء على نظام بشّار الأسد ومهما كان الثمن. بل إن طهران هي التي شجّعت النظام السوري على الخوض في دماء شعبه وتوريطه في حربٍ شاملةٍ تستدعي منه الاستنجاد بها كما حصل تماما، واستغلال ضعفه وحاجته لمساعدتها وتمويلها في سبيل الإطباق عليه وإجباره على القبول بوصايتها.
وبالرغم من أن المصادر تفيد بأن طهران هي التي طلبت عام 2015 التدخّل الروسي إلى جانبها، بعد أن كادت تخسر الحرب، بل خسرتها ضد فصائل الثورة السورية التي حرّرت ما يعادل ثلثي مساحة البلاد، إلا أن موسكو لم تكن بعيدة عن إرادة استغلال “الأزمة” السورية لتحقيق مصالح استراتيجية وجيوسياسية وانتقامية أيضاً في مواجهة التحالف الغربي الذي استفرد في نظرها بالعراق وليبيا، واستهان بمصالح موسكو الاقليمية والدولية. وهذا ما سوف يتجلى بشكل أكبر في الحقبة ذاتها مع ضمّ موسكو القرم وتفجير الأزمة الأوكرانية أيضا. ولا شك في أنه كان للتدخّل الروسي الدور الحاسم في حرمان الثورة السورية من تحقيق أيٍّ من أهدافها، وفي مقدمة ذلك إسقاط رأس النظام.
لقد قرّر الروس منذ البداية أخذ سورية رهينة يستخدمونها في نزاعاتهم الدولية، ويقدّمونها طُعما للدول التي تسعى إلى النفوذ في تعزيز علاقاتهم الإقليمية وحرمان الشعب السوري من أي دورٍ في تقرير مصيره وبناء مستقبله. ولا يزال هذا الموقف على حاله منذ 13عاماً، ولم تسمح لا طهران ولا موسكو بتغييره بل، أقلّ من ذلك، بتعديلٍ، ولو جزئي، في سياسة النظام العدوانية تجاه شعبه وإصراره على الاحتفاظ بآلاف المعتقلين السياسيين في المعتقلات، واعتقال المزيد منهم وحرمان ملايين المهجّرين من العودة إلى مناطق سكناهم، عدا عن تعطيله كل المحاولات العربية والدولية لفتح نافذة على الحل السياسي والقبول بتسوية سياسية تنهي معاناة السوريين، التي وصلت إلى حدّ لم تعد المنظمّات الدولية تستبعد معه حصول مجاعة قريبة في البلاد.
التحدّي الحقيقي والأكبر للشعوب والنخب القيادية فيها هو اليوم وضع الأسس اللازمة لإقامة نظم سياسية واجتماعية تعكس مصالح الناس
هذا ما يفسّر الوضع الكارثي الذي تعيشه سورية اليوم على جميع الأصعدة، الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والانهيار الأخلاقي لسدنة نظامٍ لم يعد أمامهم وسيلة للاستمرار في الحكم وتجاوز أزمة انهيار الاقتصاد سوى تحويل البلاد إلى مصنع كبير لحبوب الكبتاغون المخدّرة وتهريب البشر والمتاجرة بهم. كما يفسّر المنحى العام الذي اتّخذته مسارات الثورات العربية التي ارتهن مصيرُها جميعا لمعادلات القوة والصراعات الإقليمية والتجاذبات الدولية، والتي تتخذ طابعا حادّا واستثنائيا في المنطقة الشرق أوسطية لما لها من حساسية في الجيوسياسة الشاملة.
هل يحكُم هذا الوضع على المجتمعات العربية بالبقاء في قبضة النظم القهرية والفاسدة والاستبدادية الى الأبد؟… بالتاكيد لا. لكنه يدفع أو ينبغي أن يدفع إلى التفكير في الدرس الثالث المهم المرتبط بدور النخب المثقفة والسياسية في التأثير في مستقبل كفاح شعوب المنطقة ومآلات ثوراتها وانتفاضاتها، التي لم تكن ثورات العقد الثاني من هذا القرن سوى الدفعة الأولى على حسابٍ كبير وعسير، بين النظم وشعوبها. وللأسف، لعب الاعتقاد السائد عند معظم عناصر هذه النخبة المُحدثة في أن فشل التغيير ناجم عن تخلّف الشعب، ومن ثم أن من العبث الاستثمار في مشاريع التغيير قبل أن يتطور الشعب ويتغلب على أميّته وجهله وتخلّفه، ولا يزال يلعب دورا مدمّرا في تعميق الهوة بين الطرفين، ويساهم في إيجاد الفراغ السياسي، ودفع الجمهور إلى تسليم قياده إلى أناس بسطاء أو أصحاب مصالح أو إلى فتوّاتٍ ضيقي الأفق. وهذا ما يحرم الحركات الاجتماعية الكبرى من قيادة تعي، إلى حدٍّ أو آخر، تعقيدات السياسة وتقلبات الأحداث ودروس التاريخ وثقل الجغرافيا.
الخلاصة ليس إسقاط النظم السياسية المنافية لروح العصر وحقوق الإنسان الأساسية هو الذي يشكّل اليوم التحدّي الحقيقي والأكبر لمستقبل المجتمعات العربية ولنخبها الواعية، فتكفي نظرة سريعة على إنجازاتها لندرك أنها خسرت الرهان بالفعل، وأصبحت نظما ساقطة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. التحدّي الحقيقي والأكبر للشعوب والنخب القيادية فيها هو اليوم وضع الأسس اللازمة لإقامة نظم سياسية واجتماعية تعكس مصالح الناس، وتردّ على تطلّعاتهم الإنسانية إلى المساواة والعدالة والحرية والكرامة والرضى والسعادة. ولا يمكن ذلك من دون انخراط النخب الاجتماعية والمثقفة، في هذه المعركة التاريخية، مع الشعب ومن أجله، والتي هي معركة تحرير الفرد والمجتمع بمقدار ما هي معركة تحقيق ذاتها الذي لا يمكن أن يكون خارج الشعب ولا من باب أوْلى ضدّه.