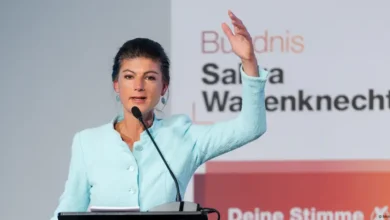من فيليب حبيب إلى توماس باراك: مأزق الحلول الشاملة في لبنان

كتب البراق شادي عبدالسلام في صحيفة العرب.
في جوهرها تُعتبر مبادرة توماس باراك محاولة لإعادة تعريف مفهوم السيادة الوطنية في لبنان عبر تفكيك البنية المعقدة لـ”دولة داخل الدولة” التي شكلها نفوذ الوكلاء الإقليميين.
تتجدد فصول الأزمة اللبنانية وكأنها مسرحية تتغير فيها الوجوه وتبقى الحبكة الدرامية ثابتة تحت عنوان “إفشال الدولة ومؤسساتها”. من فيليب حبيب، المبعوث الرئاسي الأميركي ذي الأصول اللبنانية الذي انطلق في مهمته عام 1982، إلى توماس باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب والذي يحمل أيضًا أصولًا لبنانية، تبرز دبلوماسية أميركية فاعلة تهدف إلى تجاوز منطق إدارة الأزمات نحو إيجاد حلول جذرية ومستدامة. بينما سعى حبيب لوقف نزيف الحرب الأهلية وحصار دامٍ لبيروت، يواجه باراك اليوم تحديات جيوسياسية إقليمية وداخلية تتميز بـ”لا حرب ولا سلم،” مع تزايد نفوذ حزب الله على الدولة اللبنانية في سياق تتداخل فيه المصالح الإقليمية مع الانقسامات الداخلية.
في عام 1982 انطلقت المهمة الدبلوماسية للمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للشرق الأوسط، فيليب حبيب، بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب الأهلية في لبنان. فيليب حبيب، الدبلوماسي الأميركي البارز من أصول لبنانية مارونية، كان استجابة أميركية للاجتياح الإسرائيلي للبنان، المعروف في الأدبيات العسكرية بـ”عملية سلام الجليل”، وما تبعه من حصار بيروت الذي استمر 93 يومًا بعد مقاومة من الفصائل الفلسطينية. جاءت هذه المهمة بتكليف من الرئيس الأميركي رونالد ريغان في إطار إستراتيجية ريغان للشرق الأوسط، المعروفة أيضًا بـ”مبدأ ريغان”، التي ركزت على مواجهة التوسع السوفييتي وتعزيز الاستقرار الإقليمي ودعم الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة. كان الهدف الإستراتيجي يتمثل في نزع فتيل الأزمة، وتأمين ممرات آمنة لانسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية، التي كانت القوة العسكرية المهيمنة في بيروت آنذاك.
على هذا الأساس تميز النهج الدبلوماسي لحبيب بما عُرف بـ”دبلوماسية التناوب”، حيث شملت المفاوضات المكثفةُ الرحلات المكوكيةَ واللقاءات مع مختلف الأطراف، بدءًا من بشير الجميل في بيروت وحتى حافظ الأسد في دمشق، مع فترات ضغط عسكري إسرائيلي. كان هذا الضغط، الذي أشرف عليه وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون، يهدف إلى إجبار الأطراف الفلسطينية واللبنانية على تليين مواقفها في إطار تفاوضي متصل. نجحت جهود حبيب في التوصل إلى اتفاق رعته الولايات المتحدة، نص على خروج القوات الفلسطينية من بيروت تحت إشراف قوة متعددة الجنسيات، ما ساهم في احتواء الأزمة. لكن هذا النجاح ترك فراغًا أمنيًا أدى إلى فتح الباب أمام أحداث مأساوية لاحقة.
بعد أسابيع قليلة من الانسحاب الفلسطيني، وفي ظل الفراغ الأمني، اهتز المشهد السياسي اللبناني باغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل في 14 سبتمبر 1982. أثار هذا العمل الإرهابي موجة من الغضب، ومهد الطريق لأحداث عنف. بعد ساعات من الاغتيال قامت ميليشيات القوات اللبنانية، بتواطؤ وتسهيل من الجيش الإسرائيلي الذي أضاء سماء بيروت بالقنابل الضوئية، باقتحام مخيمي صبرا وشاتيلا. وعلى مدى ثلاثة أيام ارتكبت مجازر راح ضحيتها مئات المدنيين العزل، ما أثار إدانة دولية واسعة وأجبر إسرائيل على تشكيل لجنة تحقيق رسمية.
في محاولة لإنهاء حالة الحرب، تم التوصل إلى “اتفاق 17 أيار” عام 1983 بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية. نص الاتفاق على إنهاء حالة الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية، لكنه واجه معارضة إقليمية ودبلوماسية، خاصة من سوريا. أدى هذا الرفض إلى انهيار الاتفاق بعد أن ألغاه الرئيس اللبناني أمين الجميل في 5 مارس 1984 من جانب واحد. فشلُ الاتفاق خلق فراغًا أمنيًا وصراعًا على النفوذ، دفع القوى الإقليمية والمحلية إلى التنافس للسيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية. تزامنًا مع فشل الاتفاق والانسحاب الإسرائيلي الجزئي، اندلعت “حرب المخيمات” بين 1985 و1988، وهي صراع دموي بين حركة أمل الشيعية والفصائل الفلسطينية، تسبب في حصار قاسٍ على مخيمات اللاجئين في برج البراجنة وصبرا وشاتيلا وتل الزعتر، وسقوط آلاف الضحايا.
في سياق جيوسياسي متقارب إلى حد ما، وبعد عقود من تلك الأحداث المأساوية التي مزقت النسيج المجتمعي اللبناني، جاءت مهمة توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص، لتعكس تحولًا في المقاربة الأميركية. لم يكن لبنان في خضم حرب أهلية شاملة كما كان في زمن حبيب، بل هو اليوم في حالة “لا حرب ولا سلم” مع إسرائيل، مصحوبة بأزمة اقتصادية وانقسامات سياسية ناتجة عن تفاعلات ما بعد الحرب الأهلية على المشهد السياسي الداخلي والإقليمي. انطلقت مهمة باراك بتكليف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقب أحداث 7 أكتوبر 2023 وتصاعد المواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، بعد أن حول حزب الله دولة لبنان إلى جبهة إسناد شمالية للمشروع الإيراني في الشرق الأوسط. تكليف توماس باراك، ذي الأصول اللبنانية، يهدف أولًا إلى منع تحول هذا الصراع المحدود جغرافيًا إلى حرب إقليمية شاملة. ليست مهمته مجرد إدارة أزمة عسكرية أو وساطة لانسحاب كما في مهمة حبيب قبل أربعين عامًا، بل محاولة لتقديم حلول شاملة ومستدامة، تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد الأمني والعسكري اللبناني من خلال ما يُعرف بـ”الورقة الأميركية”، في مسعى لتجاوز مأزق إدارة الأزمات المتكررة.
تشير “الورقة الأميركية”، التي قدمها توماس باراك، إلى إطار شامل يهدف إلى ترسيخ وتوسيع نطاق اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، مع السعي للوصول إلى حل دائم وشامل شبيه باتفاق “17 أيار”. تركز الورقة بشكل أساسي على تحقيق الاستقرار على الحدود وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، عبر حصر ملكية السلاح بيد الدولة وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله. كما تدعو إلى تفعيل دور الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، مع تقديم دعم دولي ومساعدة لإعادة انتشاره العسكري في الجنوب، بالإضافة إلى الترسيم الدائم للحدود بين لبنان وإسرائيل، وكذلك بين لبنان وسوريا من جهة أخرى.
على هذا الأساس يمكن اعتبار “ورقة توماس باراك” خارطة طريق جيوسياسية تستهدف تغيير قواعد الاشتباك القائمة في الجنوب اللبناني وفي لبنان ككل، من خلال إقامة منطقة عازلة خالية من أي وجود عسكري لحزب الله أو غيره من القوى غير الرسمية، وذلك بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701. سلطت هذه الورقة الضوء على ضرورة إعادة بسط سلطة الدولة اللبنانية بشكل كامل على أراضيها، وهو شرط أساسي لضمان الاستقرار الإقليمي. تتجاوز المقترحات الترتيبات الأمنية المؤقتة لتشمل أيضًا التطبيع الدبلوماسي مع سوريا في ملف ترسيم الحدود الشمالية، ما يشكل إقرارًا ضمنيًا بأهمية لبنان كلاعب محوري في المعادلات الإقليمية.
تُعتبر هذه المبادرة، في جوهرها، محاولة لإعادة تعريف مفهوم السيادة الوطنية في لبنان، عبر تفكيك البنية المعقدة لـ”دولة داخل الدولة” التي شكلها نفوذ الوكلاء الإقليميين. يشكل حزب الله في هذا السياق نموذجًا بارزًا لهذا التأثير، بفضل ترسانته العسكرية وقدراته التنظيمية التي تتجاوز أحيانًا قدرات المؤسسات الرسمية. امتلاكه لقرار الحرب والسلم يُعد، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023، تحديًا صريحًا لمبدأ حصرية القوة بيد الدولة اللبنانية، ما يربط مصير لبنان بشكل وثيق بأجندات إقليمية. أفرزت هذه الديناميكية حالة ازدواجية سياسية، حيث تعجز الدولة عن اتخاذ قرارات مصيرية بشكل مستقل، وتجد نفسها مجبرة على التكيف والانغماس في صراعات إقليمية لا تمتلك سلطة عليها. ومن ثم يُعتبر أي مقترح يهدف إلى فصل الأجندة الداخلية اللبنانية عن هذه التأثيرات خطوة أساسية نحو استعادة المؤسسات الدستورية لدورها وتعزيز سلطة القرار السيادي، ما يتيح للبنان تحديد سياساته الخارجية والأمنية بعيدًا عن الإملاءات الخارجية. يعمل الرئيس اللبناني، العماد جوزيف عون، المعروف بـ”رجل التوازنات”، على هذا المسار بعد أزمة دستورية كادت تؤدي إلى انهيار الدولة اللبنانية.
في تطور لافت، وبعد قرار حكومة نواف سلام بإقرار أهداف “الورقة الأميركية” وحصرية سلاح الدولة، يواجه الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) منعطفًا سياسيًا وإستراتيجيًا حاسمًا. لا يمثل هذا القرار مجرد خلاف حكومي، بل هو تحدٍ مباشر لمبدأ توازن الردع الذي استند إليه الثنائي للحفاظ على نفوذه السياسي والأمني. الرد المحتمل لا يقتصر على التعبير عن الرفض، بل قد يشمل سيناريوهات تستهدف إعادة التموضع السياسي والمؤسسي، بدءًا من داخل الحكومة وصولًا إلى الشارع، في ظل ديناميكيات إقليمية ودولية متغيرة.
تتمثل الخطوة الأولى للثنائي الشيعي في استثمار الأدوات الدستورية لعرقلة هذا التوجه أو تقويضه، وهي أدوات سبق أن أتقنها في الماضي. يبرز هنا خياران رئيسيان:
الخيار الأول: الاستقالة وسحب الغطاء الميثاقي من الحكومة، وهو تكتيك سبق استخدامه في عام 2006 عندما استقال وزراؤه من حكومة فؤاد السنيورة، ما وضعها في خانة “حكومة أمر واقع”. يلعب البرلمان هنا دورًا حاسمًا في حسم الصراع السياسي، حيث قد يتبع الثنائي استقالته من الحكومة بالنزول إلى المجلس النيابي لطرح الثقة بها، ما يحول الخلاف من مسألة وزارية إلى مواجهة برلمانية شاملة، تؤدي إلى تآكل شرعية السلطة التنفيذية.
الخيار الثاني: التعطيل من الداخل، حيث يمكن للثنائي البقاء في الحكومة واستخدام حق النقض غير المعلن، المعروف بـ”التوقيع الثالث”، لعرقلة أي قرار رئيسي. هذا الأسلوب، الذي يُعتبر غير أخلاقي سياسيًا، يحول الحكومة إلى هيئة عاجزة عن تنفيذ بنود “الورقة الأميركية” أو أي خطوة سيادية تتعارض مع مبدأ دولة المقاومة.
في حال فشلت الخيارات السياسية، قد ينتقل الثنائي إلى إستراتيجيات أكثر حدة في الشارع. يتضمن ذلك التعبئة الشعبية عبر اعتصامات منظمة، في محاولة لوضع ضغط مباشر على الحكومة، وهو ما يشبه سيناريو “القمصان السود” في 2019 أو أحداث 7 أيار 2008. قد يتطور هذا السيناريو إلى إستراتيجية “الفوضى المنظمة”، حيث يتم استخدام أدوات غير مباشرة لعرقلة عمل المؤسسات المالية والإدارية، ما يعمق الأزمة ويثبت أن الدولة لا يمكن أن تعمل بفاعلية دون التوافق مع الثنائي الشيعي، وهو ما يفرض عليه العودة إلى طاولة التفاوض بشروط جديدة تحددها التطورات الإقليمية في صراع طهران مع تل أبيب وواشنطن.
وفي ضوء ما سبق تكمن المفارقة في أن كلا من مهمة فيليب حبيب وتوماس باراك، رغم اختلاف السياقات الزمنية والسياسية، تجسدان جوهر التحدي الأميركي في لبنان. ولئن نجحت دبلوماسية حبيب في تحقيق “حلول قصيرة الأمد” لأزمة عسكرية حادة، فإنها أخفقت في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، تاركةً وراءها فراغًا أمنيًا سمح بحدوث مآسٍ إنسانية وفشل اتفاقات السلام. أما مهمة باراك فجاءت بمقاربة مختلفة، تسعى إلى تجاوز “دبلوماسية الأزمات” نحو “حلول شاملة” تستهدف إنهاء حالة “الدولة داخل الدولة”. ومع ذلك، تواجه هذه المقاربة الشاملة اليوم تحديًا مشابها لما واجهته اتفاقية 17 أيار، وهو الرفض من قوى إقليمية ومحلية ترى في هذه الحلول تهديدًا لنفوذها. إن أي حل مستدام في لبنان لا يمكن أن ينجح دون توافق سياسي داخلي وإقليمي واسع. في ظل الديناميكيات المعقدة، يبقى السؤال: هل سيتمكن لبنان، بدعم دولي، من تجاوز مأزق “التوازن” القائم على السلاح غير الشرعي، أم أنه سيبقى عالقًا في حلقة مفرغة من الأزمات، حيث تُدار الصراعات بدلاً من حلها بشكل نهائي؟ مسار لبنان المستقبلي يتوقف على قدرة قواه السياسية على تقديم مصلحة الدولة على مصالحها الفئوية، وعلى رغبة المجتمع الدولي في دعم حل حقيقي ومستدام لا يكتفي بإخماد الحرائق مؤقتًا.