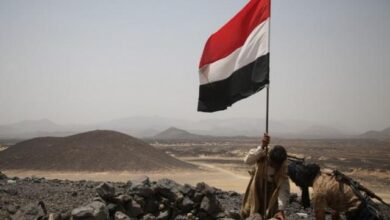في وعود توسيع اللامركزية في الجزائر…

كتب محمد سي بشير في صحيفة العربي الجديد.
وعد المرشّحان لرئاسيات الجزائر (نظّمت في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، وفاز عبد المجيد تبّون بعهدة رئاسية ثانية)، عبد المجيد تبّون وعبد العالي حسّاني برفع عدد ولايات (محافظات) الجزائر إلى ما فوق المائة (كانت 48 ولاية قبل أن يرفع تبّون أخيراً عددها إلى 58 ولاية أغلبها في الجنوب)، وهو وعد انتخابي قد يتجسّد أو لا يتجسّد، إذ يُعَدّ من طموحات المرشّحَين لجلب الانتباه إلى برنامجيهما، وتروي شخصيهما لدى الوعاء الانتخابي، لكن من وراء هذه الدعوة بعض المُؤشّرات التي يكون صانع القرار في الجزائر قد انتبه إليها، ويُراد لها أن تكون حقيقةً بالنظر إلى التغييرات التي طاولت الجزائر في آخر عقودٍ، ومنها وجوب التكيّف مع ارتفاع عدد السكّان (50 مليون نسمة في غضون الأعوام الخمسة المقبلة)، ووجوب الاستفادة من التراب الوطني الشاسع (2.3 مليون كيلومتر مربع، مع طوبوغرافيا صحراوية واسعة وغير مأهولة)، مع وجود قدرات ضامرة يمكن استغلالها لمواجهة تحدّيات العقود المقبلة.
لا يمكن الإعلان عن زيادة عدد دوائر جهوية على غرار الولايات (المحافظات) من دون العلم (الدراية) بتغير قواعد اتّخاذ القرار بين المستويين المركزي والجهوي – المحلّي، ومن دون أن يتعلّق ذلك بتغير مقاربات السياسات العامّة خاصّة في بعض المجالات مثل التربية والعمل والصحّة، لا سيّما في بلد شاسع المساحة لكنّه لم يجرّب اللامركزية الواسعة، وما يمكن أن يتولّد منها من تداعيات في المستويات كافّة.
بالقرب منا، في الجوار الجنوبي لأوروبا، في إيطاليا، صرّحت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأنّ حكومتها بصدد اتّخاذ قرارات غيرَ مسبوقةٍ بـ”الجهوية” في إيطاليا، وبخاصّة في مجالي العمل والتربية، بالنظر إلى تعقيدات في السياسات العامّة وجب التكيف معها، وهي قاعدة (مقاربة) تحاول كثير من الدول اعتمادها لأسباب سنذكر جانباً منها في سياق هذه المقالة، وفي الحالة الجزائرية بصفة خاصّة.
لا يمكن الإعلان عن زيادة عدد دوائر جهوية على غرار الولايات (المحافظات) من دون العلم بتغير قواعد اتّخاذ القرار بين المستويين المركزي والجهوي – المحلّي
طبعا، لا نقول إنّ التصريح الإيطالي كان له وقع على وعود المرشَّحَين، لكننا، في الوقت نفسه، نصغي، بوعي، إلى حجج حسّاني، التي ساقها لتأكيد واقعية ما يذهب إليه، ومنها أنّ اتساع المساحة، إضافة إلى تعقّد السياسات العامة، وبيروقراطية بعض المستويات الإدارية، التي أُقرّت لكنّها لم تقم بأدوارها كما يجب على غرار الدائرة (مؤسّسة إدارية بين البلدية والولاية يُعين الرئيس من يُسيِّرها، وهي ترأس إدارياً بلديات عديدة، ومنتشرة في طول التراب الجزائري وعرضه)، التي لم يبقَ لها دور، خصوصاً بعد قيام البلدية بأدوارها الإدارية في استخراج وثائق، والقيام ببعض الإجراءات بمرجعية التطبيق الواسع لسياسة الرقمنة التي سهّلت إجراءاتٍ كثيرة، واختصرت الوقت.
أمّا الرئيس تبّون، المترشّح الحرّ في الرئاسيات، فقد تحدّث في حملته الانتخابية عن تغير في إدراك صانع القرار أساسيات التنمية، ومن يُسيِّرها في المستويات الجهوية والمحلّية، واحتجّ على سبيل المثال بعدد السكّان، الذي كان إلى وقت قريب لا يتعدّى 20 مليونا، وهو سيقارب في غضون أعوام 50 مليوناً (وفق الإحصاءات الرسمية)، ما يُؤدّي إلى اعتماد مُقارَبات في السياسات العامّة قد تزيد الدولة من خلالها جرعات الإدارة اللامركزية، أو منح صلاحيات واسعة لكلّ من الولاية (المحافظة) والبلديات، وهما مجالان يسعى الرئيس المترشّح، كما قال، إلى إصلاح القوانين الأساسية التي تُسيِّرها، إلى جانب وعوده بتغيير قوانين أساسية كثيرة، تبعاً (كما قال) إلى المُسبّبات والدواعي نفسها، أي تغيّر ظروف الجزائر ووجوب اعتماد مُقارَبات مُبتكَرة في تسيير دولة لها مشروع تبوُّء مكانة القوّة الإقليمية، استراتيجياً واقتصادياً، ولديها مقدّرات تريد استثمارها، لكن بمنهجيات جديدة أضحت ضروريةً وحيويةً بالنسبة إلى الوضع الحالي والمستقبلي للجزائر.
حكم بلد بـ 20 مليون نسمة لا يمكن أن يتمّ بذات المُقارَبة لبلد سيصل تعداد سكّانه إلى 50 مليوناً
عند العودة إلى هذا المشروع و دواعيه، نجد أنّ صانع القرار في الجزائر يكون قد وضع في حساباته خياراتِ تغيير مقاربات السياسات العامّة لتحقيق أهداف كبيرة ولكنّها، في المقام الأول، ستحقّق التحوّل الذي يطالب به الجزائريون، وتأمله السلطة (أو وعدت بتحقيقه)، وهو التحوّل من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الحقيقي، المبني على نموذج اقتصادي تلعب فيه الأدوات الاقتصادية (الاستثمار، والبورصة، والصادرات خارج قطاع المحروقات، وإصلاح منظومة التربية والتعليم العالي بما يناسب تحوّلات سوق العمل… إلخ) الدور المنوط بها، بعيداً عن الريع والاتكالية، التي تعوّد عليها الاقتصاد. ومن تداعيات هذا التحوّل حصول ما يُعرَف بصعود البرجوازية، والسعي إلى الرفع من قيمة المعادلة الضريبية بما يُؤدّي إلى ترقية المُراقبة على صرف المال العام، والرقابة على عمل المؤسّسات، أي التحوّل التدريجي نحو تبنّي الأدوات التي تشبه (أو تكون) الديمقراطية الحقيقية، أو إعادة تأسيس العقد الاجتماعي من جديد، وهو من مطالب الجزائريين وطال انتظاره، وها هو قد يتحقّق من خلال هذا التحوّل.
من الطبيعي في بلد بهذه المساحة الشاسعة، وبالاستثمار غير المتوازن لأدوات التنمية الاقتصاد بين الشمال والجنوب، أن تُبتكَر حلولٌ لإشكاليات الاكتفاء الذاتي الغذائي، خاصّة مع وجود إمكانات ضخمة لاستصلاح أراضٍ، واستغلال المياه الجوفية للسقي، إضافة إلى إمكانية تحويل الأيدي العاملة بالتكوين المثالي المتناسب مع تلك الاحتياجات، وبذلك تكون تلك الوعود هي نقل لإدراك صانع القرار لفرصة الانتخابات لاقتراح مثل هذا المشروع الطموح، الذي من مخرجاته (في قراءة سريعة) ثلاثة أهداف يمكنها التجهيز لتغيّر صورة الجزائر مستقبلاً رأساً على عقب.
يتمثّل المَخرَج الأول في استغلال إمكانات بلدٍ لا يزال يعاني قصوراً كبيراً في مجالات كثيرة في السياسات العامة، ويحتاج إلى مشروع كبير يمتصّ ذلك القصور، و يُشكّل قاعدةً لتنمية تنقل البلدَ من الريع الطاقوي إلى الاقتصاد الحقيقي، بل إلى قوّة اقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل لعوامل الطاقة الشمسية، والمياه الجوفية، إضافة إلى تكييف التعليم والتكوين في المستويات كافّة، لتحويل السكّان من الشمال إلى الجنوب، مع فرص عمل واستغلال للملايين من الهكتارات في الزراعة، وما يترتب عليه من إمكانات لإيجاد صناعات غذائية ومُخرَجات لتطوير التكنولوجيات الخاصّة بتسيير مساحات شاسعة، ممّا يمنح آفاقاً لتكوين بحثيّ كبير (الأقمار الاصطناعية، والمُسيَّرات، والاستغلال الأمثل للمياه الجوفية، واستحداث مُقارَبات جديدة في الزراعة… إلخ).
تحتاج الجزائر إلى الانتقال من الريع إلى الاقتصاد الحقيقي، وتجسيد التحوّل الحقيقي نحو التغيير والديمقراطية
يشير المَخرَج الثاني إلى تداعيات ابتكار نموذج اقتصادي حقيقي يُخرِج البلد من الريع الطاقوي، ويضع الأسس لتعامل مجتمعي وفق عقد اجتماعي جديد للمواطنة، يرتكز على دفع الضرائب، بهدف إخرج البلد من الاستعصاء عن التغيير، والتحوّل نحو الديمقراطية، ذلك أن دفع الضرائب في الاقتصاد الحقيقي يُؤدّي حتماً، كما جرى في تجارب ديمقراطية عبر العالم، إلى تأسيس مُقارَبات المراقبة لصرف المال العام، وينقل الإدارة برمّتها إلى ما يُعرَف بإقرار المسؤولية، وبالمساءلة ورديفتهما المراقبة، لتسيير المؤسّسات، إضافة إلى ترقيةٍ منهجيةٍ لاختيار الممثّلين (المُنتخبين) في مستوى المؤسّسات البرلمانية والمحلّية.
بالنسبة للمَخرَج الأكثر أهمّية، من آفاق التحوّل باللامركزية إلى الاقتصاد الحقيقي يسمح بالتأسيس لمقاربة حكم تحدّث عنها الرئيس تبّون في حملته الانتخابية، ذلك أنّ حكم بلد بـ 20 مليون نسمة لا يمكن أن يتمّ بذات المُقارَبة لبلد سيصل تعداد سكّانه إلى 50 مليون نسمة. وهنا نصل إلى المتطلّب الأكبر، وهو ثلاثية الكفاءة – النجاعة – الرشادة، التي ستصبح ركائزَ في التعيين، وفي تحميل المسؤولية، وفي المساءلة، وفي الدورة كلّها، التي تعمل على أساسها السياسات العامّة، بعيداً عن المحاباة والمحسوبية، أو الإفلات من العقاب عند ارتكاب التجاوزات، أو الوقوع في شبهات الفساد.
بالرغم ممّا جرى كلّه (ويجري) من محاولة بعضهم تعمّد الجمود، والإبقاء على قواعد الحكم كما هي من دون تغيير، إلّا أنّ الضروريات الحتمية للتطوّر ستعمل لإيجاد تلك المخارج وتحويلها حقيقةً، لأنّ الطاقة من الموارد الناضبة، والعمل، هما الكفيلان بإدامة شروط الحياة الكريمة، وعندها ستتّجه الأمور حتماً إلى حقيقتها، التي كان يجب أن ترتكز عليها داخل دائرةٍ تسمَّى الاقتصاد الحقيقي، من خلال إدارة لا مركزية تعرف الاحتياجات، وتتكيف معها، والهدف النهائي هو عقد اجتماعي جديد يحتاج إلى السواعد كلّها، ويكون في فائدة الجميع، لأنّ المشروع طموح جداً، وهو نقل البلد من الريع إلى الاقتصاد الحقيقي، وتجسيد التحوّل الحقيقي نحو التغيير والديمقراطية.