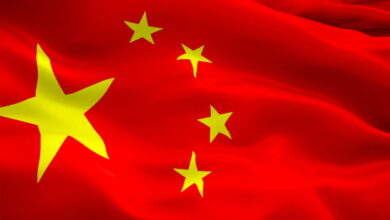في المقاربة الأميركية للأزمة اليمنية

كتب ماهر أبو المجد, في “العربي الجديد” :
في 16 من الشهري الحالي (أكتوبر/ تشرين الأول)، استخدمت الولايات المتّحدة قاذفات “بي 2” المتطوّرة في استهداف ما قالت إنّها مخازن سلاح تحت الأرض تابعة لجماعة الحوثي في محافظتَي صنعاء (العاصمة)، وصعدة (المعقل الرئيس للجماعة الحوثية)، في خطوة احتار بعضهم في توصيفها، وما إذا كانت بداية مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الناشب بين واشنطن والحوثيين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، أم أنّها عملية نوعية عابرة فرضها المنطق العملياتي، وستعود طبيعة المواجهة بين الطرفيَن إلى الاحتكام لقواعد المواجهة التي يصفها البنتاغون بـ”إضعاف قدرات الجماعة المسلّحة في اليمن على استهداف الملاحة البحرية”، ويسمّيها الحوثيون عمليات “إسناد المقاومة في فلسطين، حتّى يتحقّق وقف إطلاق النار في غزّة وفك الحصار عنها”.
لكن منطق ترتيب الأحداث وتشابكها على أكثر من صعيد، مع استخدام هذا النوع من القاذفات الاستراتيجية القادرة على حمل قنابل ذات نفاذية كبيرة في اختراق أعتى التحصينات العسكرية واللوجستية، يقول إنّ المقصود كان توجيه رسالة لطهران بأنّ الولايات المتّحدة قد تستخدم أو تتيح لإسرائيل استخدام هذا النوع من سلاح الجو، إذا تخطّت طهران قواعد المواجهة المتبادلة بينها وبين الكيان الصهيوني، وليس خافياً على أحد نهم بنيامين نتنياهو لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، لكنّه محاصر بعدم امتلاكه المقاتلات القادرة على حمل الأسلحة اللازمة لتدمير منشآت شديدة التحصين، ومن الواضح أنّ حسابات واشنطن تقتضي عدم تصعيد المواجهة إلى مرحلة اللاعودة، وفي الوقت ذاته ترسل رسالة مفادها أنْه ليست لديها خطوط حمراء في مسألة مناصرة إسرائيل وضمان تفوّقها.
وبالعودة إلى طبيعة المقاربة الأميركية للأزمة اليمنية الراهنة، ومقتضيات التعامل مع الحوثيين، وفق تطوّرات المرحلة الراهنة المفتوحة على الاحتمالات كلّها، وتصورات واشنطن لطبيعة الحلّ في اليمن، فإنّ كشفها يستلزم العودة بالتاريخ قليلاً إلى الوراء، إلى مرحلة انقلابهم على مسار الانتقال الديمقراطي الذي أنتجته ثورة 11 فبراير/ شباط عام 2011، وتحديداً إلى 21 سبتمبر/ أيلول عام 2014. فبالرغم من إدانة واشنطن لانقلاب الحوثيين على المرحلة الانتقالية وسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم اعترافها بسلطتهم، إلّا أنّ موقفها، وإنْ كان متّسقاً مع توجّهاتها في دعم التحوّل الديمقراطي في بلدان “الربيع العربي”، فإنّه أيضاً كان ملحوقاً ومتّصلاً بالموقف الإقليمي السعودي – الإماراتي ومقاربته الأمنية والجيوسياسية لمستقبل اليمن اعتماداً على أمرَين. الأول أنّ الملف اليمني، ومنذ عقود مضت، كان منظوره الغربي عموماً، والأميركي خاصّةً، منظوراً سعودياً، أي أنّ اليمن كان ملحقاً بالسعودية في التعاملات الغربية مع ملفّات الشرق الأوسط. والأمر الثاني أنّ الرياض كانت المشرفة على طبيعة التحوّل في اليمن، من خلال المبادرة الخليجية 2012، التي ابتدعت مساراً سياسياً توافقياً للثورة اليمنية.
من الواضح أنّ حسابات واشنطن تقتضي عدم تصعيد المواجهة إلى مرحلة اللاعودة، وفي الوقت ذاته ترسل رسالة مفادها أنْه ليست لديها خطوط حمراء في مسألة مناصرة إسرائيل وضمان تفوّقها
وفق هذين المعطيين، فإنّ الإدارة الأميركية، إدارة الرئيس بارك أوباما، لم تعارض “عاصفة الحزم” التي انطلقت في 26 مارس/ آذار 2015 لمجابهة انقلاب مليشيا الحوثي ونصرة الشرعية اليمنية، وفق الأهداف المعلنة للعملية، بل ساندتها وقدّمت لها الدعم العسكري واللوجستي، وإن كان وفق مقاربة أميركية غير مُعلَنة من شأنها زجّ السعودية في المستنقع اليمني، كما بات بعضهم يتصور، قياساً على واقع اليوم ونتائجه. والواقع أنّ واشنطن أعادت تعريف الحوثيين أكثر من مرّة خلال سنوات الصراع العشر الماضية وفق مقتضيات المصلحة الاقتصادية، والتحكّم بمعادلة القوّة وتوازناتها في المنطقة. أولاً من خلال الدعم اللامحدود بداية لـ”عاصفة الحزم” لإيقاف انقلاب الحوثيين، ثمّ التأكيد على أنّه لا حلَّ في اليمن إلّا من خلال مسار سياسي سلمي يضمن وجود الحوثيين وتصديرهم للمستقبل من خلال ما عرف بمبادرة وزير الخارجية الأميركي في عهد الرئيس أوباما جون كيري، التي نصّت على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون شريطةَ انسحابهم من العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة لطرف ثالث لم تحدّده المبادرة.
والواقع أنّه صاحَب هذه المبادرة تغيران مهمّان، يمكن القول إنّهما البداية الحقيقية لتشكلّ الصورة النمطية أو المقاربة الأميركية التي دُشِّنت في نهاية عهد الرئيس أوباما. الأول، النظر للحوثيين أقلِّيةً أصيلةً في المجتمع اليمني يجب ضمان حقهم في الوجود والمشاركة السياسية، وهذا الأمر لا يتناسب بالمطلق مع طبيعة الحركة الحوثية ومشروعها وإرثها التاريخي وفهم اليمنيين لها. والثاني، التضييق على السعودية في الحصول على صفقات الأسلحة، وخصوصّاً الهجومية منها. لكنّ هذه المقاربة تغيّرت نوعاً ما في عهد الرئيس دونالد ترامب، الذي قارب الأزمة اليمنية وطبيعة المواجهة السعودية – الحوثية من منظور اقتصادي بحت، وفتح مخازن الأسلحة الأميركية للسعودية، وعرضها في المؤتمرات الصحافية، وكأنّه مسعّر في بازارٍ للأسماك. ومع ذلك، شهدت ولايته أحداثاً شكلَت ما يشبه الصدمة غير المتوقّعة للسعودية، حينما تبنّى الحوثيون استهداف منشأتين لـ”أرامكو” في محافظتي بقيق وهجرة خُرَيص (شرق السعودية)، في عملية سمّاها الحوثيون “توازن الرعب”، وحينها لم تكن ردّة الفعل الأميركية مناسبةً لتصوّر السعودية، التي كانت تعاني من أزمة نقص حادٍّ في منظومة الدفاع الجوي “باتريوت”، وربما تيقَّنت الرياض حينها أنّ هناك من يعدّ لها مسرح حرب طويلة في اليمن.
ظهر أنّ واشنطن بعد 7 أكتوبر مستعدّة لخوض معاركَ في أكثر من جبهة لأجل إعادة فرض معادلة الردع الإسرائيلية
بداية عهد الرئيس جو بايدن شهدت جفاءً أكثر في العلاقة مع السعودية، وتعهَّد رجل البيت الأبيض الجديد بإنهاء الأزمة في اليمن بتسوية سياسية، وتبدّا للكثيرين أنّ عهد أوباما أطلّ برأسه مجدَّداً مع تسمية البيت الأبيض أوّل مبعوث خاصٍّ إلى اليمن، هو تيموثي ليندركينغ. لكنّ تطورات إقليمية واقتصادية غيرت كثيراً في الموقف الأميركي، أبرزها المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي في 2022، وكذلك تخفيض السعودية إنتاجها من النفط، وهما أمران أدّيا في نهاية الأمر إلى قيام بايدن بزيارة إلى الرياض في أغسطس/ آب عام 2022، وهي زيارة خالفت جميع تصريحات الرئيس الأميركي، الذي حمل معه مشروع التطبيع، وما عرف بــ”صفقة القرن”. حينها عاد الملفّ اليمني ليكون المتغيّر التابع في العلاقات السعودية الأميركية.
العام 2023، كان شاهداً على أبرز التحوّلات في المقاربة الأميركية للملفّ اليمني، ففيه أصبحت واشنطن طرفاً رئيساً في المواجهة المباشرة في اليمن، بعد أن كانت خلال سنوات الصراع الماضية تقوم بدور المراقب وضابط الإيقاع، وهذا التحوّل الراديكالي كان مدعاه فكّ الحصار عن إسرائيل، الذي فرض تابعاً لـ”طوفان الأقصى”، وأحد أبرز تبعات الحرب المجنونة التي تشنّها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزّة.
ديناميكية الصراع الذي اندلع في 7 أكتوبر (2023)، وخريطة التوازنات في المنطقة، فرضت على واشنطن الهرولة بأساطيلها العسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط للاحتشاد وراء حليفها التاريخي والأيديولوجي الأكثر أهمّيةً (إسرائيل)، وظهر أنّ واشنطن مستعدّة لخوض معاركَ في أكثر من جبهة وأكثر من صعيد لأجل إعادة فرض معادلة الردع الإسرائيلية، واحدة من تلك الجبهات كانت جبهة الحوثيين في اليمن، التي أعلنت المساندة لفلسطين من خلال عملية استهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشنّ عمليات مباشرة باتجاه الأراضي المحتلّة في فلسطين.
ستفرز مرحلة المواجهة المحدودة القائمة الآن مقاربةً جديدةً اعتماداً على الردّ الإسرائيلي المنتظر على إيران ونتائج الانتخابات الأميركية
والملاحظ في هذا السياق أنّ واشنطن، وفي خضمّ مواجهتها المباشرة مع الحوثيين، عبر تحالفها المسمَّى “تحالف الازدهار”، تريد المحافظة على مقارباتها الجيواستراتيجية للأزمة اليمنية وتصوّراتها لطبيعة الحركة الحوثية من خلال منظورين مهمين: منع التصعيد الإقليمي ضدّ إسرائيل والمحافظة على نطاق محدّد ومُتحكَّم به للمواجهات، والإبقاء على هامش كبير لتحقيق تسوية سياسية في اليمن تضمن وجود الحوثيين وتصديرهم إلى المستقبل. هذا المنظور بالذات يعني أنّ واشنطن ما زالت تحتفظ بتعريفها الثابت للحوثيين، الذي يتماشى مع مصالحها وتصوّراتها للتوازنات في الإقليم بعيداً عن التطوّر الحالي الذي فرضته الحرب الصهيونية على قطاع غزّة. أي أنّ واشنطن التي ترفض الاعتراف بأنّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر متّصلة بالحرب والحصار على غزّة، ما زالت تترك هامشاً كبيراً لعودة المسار السياسي في اليمن إذا توقّف الحوثيون عن شنّ هجماتهم على الملاحة البحرية.
الحوثيون هم أيضاً نجحوا في الحفاظ على مبرّر تدخّلهم من خلال تأكيداتهم المستمرّة أنّ الهجمات التي ينفّذونها تستهدف ما له علاقة بالكيان الصهيوني حتّى تتوقّف الحرب، ولا تستهدف حرّية الملاحة، وهذا الأمر جعل المجتمع الإقليمي والدولي يتحرّج كثيراً في اتّخاذ موقفٍ حاسمٍ ضدّ الحوثيين في اليمن، بينما تواصل إسرائيل وبلا هودة حرب الإبادة الجماعية ضدّ المدنيين في فلسطين.
الخلاصة أنّ الولايات المتّحدة ربّما تعيد الآن تقييم الحركة الحوثية في اليمن بعيداً عن التصورات السابقة، وأنّ مرحلة المواجهة المحدودة القائمة الآن ستفرز مقاربةً جديدةً بعد أن يكتمل شرطاها المؤجلان؛ الردّ الإسرائيلي المنتظر على إيران، وكيف ستتعامل الأخيرة، ونتائج الانتخابات الأميركية القريبة.