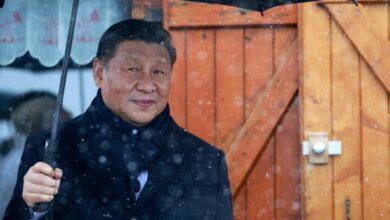تونس في ستّ سنوات من حكم قيس سعيّد

كتب محمد خليل برعومي, في العربي الجديد:
مرّت ستّ سنوات منذ صعد قيس سعيّد إلى قصر قرطاج بوصفه الرئيس الذي سيعيد السياسة في تونس إلى معناها الأخلاقي. لكنّ التجربة التي بدأت بوعد تصحيح المسار انتهت إلى عزلة متزايدة، ودولةٍ تتحدّث أكثر مما تفعل. بين خطاباتٍ تنزل آخر الليل كدروسٍ في الوطنية وواقعٍ اقتصادي يزداد هشاشة، لم تعد المسافة بين القول والفعل مجرّد فجوة في الأداء، بل صارت جوهر الحكم نفسه.
صعد سعيّد في خريف 2019 إلى الحكم بصفته “الرجل النزيه القادم من خارج المنظومة”، يحمل خطاباً أخلاقيّاً صارماً ضدّ الفساد والانتهازية الحزبية. قدّم نفسه صوتاً للشعب الصامت ورمزاً للقطيعة مع الطبقة السياسية التي أنهكتها المناورات بعد الثورة. رآه تونسيون كثيرون وعداً بالاستقامة والعدل، لا مجرّد رئيسٍ جديد. وبعد ستّ سنوات في الحكم، تراجع الوعد إلى سؤال ثقيل: هل تحقق مشروع الحكم أم تاه في صدى الخطابات التي لا تنتهي؟
منذ البداية، بنى قيس سعيّد شرعيته على فكرة بسيطة: الشعب يريد. استخدم لغة أخلاقية تُدين الجميع، وتضع نفسه خارج الصراع السياسي، باعتباره صوتاً فوق الأحزاب وممثلاً للإرادة العامة. لم يكن حزباً ولا برنامجاً، بل فكرة تقوم على أن الحكم يجب أن يعود إلى الشعب مباشرة من دون وسائط. وحين تحوّلت هذه الفكرة إلى ممارسة، أعادت إنتاج ما كانت ترفضُه، متمثّلا بتمركز السلطة بيد شخص واحد، مع فارق أنه هذه المرّة باسم الشعب.
بعد ستّ سنوات، صارت تونس تعيش وضعاً سياسيّاً منغلقاً، يذكّر بمركزية الحكم ما قبل الثورة. أعاد الرئيس صياغة الدستور سنة 2022 على نحو يُركّز السلطات في القصر الرئاسي، وحلّ البرلمان، وعيّن حكومة بلا وزن سياسي، وأدار البلاد عبر المراسيم. بهذا الشكل، تحوّل النظام إلى رئاسوية مطلقة تحكُمها شخصنة القرار، لا مؤسّسات التوازن والمساءلة. أما القضاء، الذي وُعد بتحريره، فقد ازداد خضوعاً للسلطة التنفيذية، وتحوّل إلى فضاء للملاحقات السياسية والانتقام من المعارضين وزجّ أصحاب الموقف والرأي والكلمة داخل السجون، الذين يعدّون بالمئات.
أصبحت العلاقة بين الدولة والمواطن علاقة خوفٍ متبادل
وفي الاقتصاد، لم تظهر سياسات فعلية يمكن تقييمها. لم يكن ثمّة برنامج إصلاحي واضح، ولا خطط هيكلية قابلة للتنفيذ. ما جرى لم يكن سياسات رمزية بقدر ما كان تصريفاً للقول من دون إنجاز فعلي، تصريحات متكرّرة، حملات غير دقيقة، إجراءات مرتجلة لا تُستكمل ولا تُنتج أثراً ملموساً. خيضت “حروب” ضدّ المضاربة ولتطهير الإدارة بعبارات فضفاضة، لكنها انتهت بلا نتيجة، لأنها لم تُترجم إلى سياسات عمومية أو إصلاح مؤسّساتي منظم. وبدل أن يتحسّن الأداء الاقتصادي، تعمّق العجز المالي، وارتفع التضخّم، وتآكلت الطبقة الوسطى، فيما ازدادت تبعية الدولة للاقتراض الداخلي بعد فشل التفاهم مع صندوق النقد الدولي. والنتيجة ركود عام في الاقتصاد وتراجع في الثقة. انكمش القطاع الخاص خوفاً من عدم وضوح التوجهات، والاستثمار الأجنبي جفّ، والمجتمع فقد الأمل في الإصلاح. لم يكن المواطن يرى تغيّراً في الأسعار، ولا في الخدمات، بل يسمع تصريحات ليلية تُحمّل أطرافاً مبهمة مسؤولية الأزمة: “الاحتكار”، “اللوبيات”، “المضاربون”، “الخونة”. لم يكن ثمّة مشروع اقتصادي يُدار، بل خطاب دائم عن المؤامرة والعرقلة، يملأ الفراغ الذي تركه غياب الفعل.
سياسياً، أفرغ النظام الحياة العامة من التعدّد. تحوّلت الأحزاب إلى ظلال بلا فاعلية، والانتخابات التشريعية الأخيرة مرّت وسط عزوف واسع من الناخبين. يعيش الإعلام تحت ضغط مباشر أو ذاتي، والنقابات تُحاصر. ومع انكماش الحقل السياسي، لم يبقَ صوت مسموع سوى صوت الرئيس. لكنّ هذا الصوت لم يعد يتحدّث من المنصّات الرسمية، بل من الفضاء الرقمي في ساعات الليل المتأخّرة. اعتاد الرئيس أن يخاطب التونسيين عبر مقاطع فيديو تُنشر بعد منتصف الليل أو قُبيل الفجر، من مكتبه في قرطاج أو من ميدان عام. خطابات طويلة، مليئة بالتعليق على الأحداث اليومية، تُخاطب الشعب بصيغة الواعظ أو المعلّم، وتقدّم السياسة بوصفها تصحيحاً أخلاقيّاً لا عملاً مؤسّساتياً. وهكذا تحوّل التواصل السياسي من فعل عمومي إلى خطابٍ أحاديٍّ متواترٍ يخرج من القصر ليغيب فيه ثانية.
في السنوات الستّ، لم يعد معنى “الشعب يريد” شعاراً جامعاً، بل تبريراً لكل إجراء. فباسم الشعب حُلّ البرلمان، وأعيدت صياغة الدستور، وأُقصيت الأحزاب والنقابات. لكنّ الشعب نفسه لم يُستشَر في أيٍّ من هذه الخطوات. لم تُفعّل “الديمقراطية القاعدية” التي وُعد بها، وبدل أن تنتقل السلطة إلى القاعدة انتقلت كلّها إلى القمّة.
انتهى الحاكم الذي جاء ليُعيد الدولة إلى الشعب إلى إبعاد الدولة عن الشعب وإحداث شرخ بينهما
النتيجة، أن النظام الذي رُوِّج تصحيحاً لمسار الثورة، أعاد إنتاج جوهر ما ثارت عليه، من حكم الفرد وتهميش المجتمع. أصبحت العلاقة بين الدولة والمواطن علاقة خوفٍ متبادل. تخشى الدولة الشارع وتفسّر الاحتجاج مؤامرة، والمواطن يخشى الدولة التي تملك سلطة الملاحقة والتأويل. في قابس مثلاً، حين طالب الناس بحقّهم في بيئة نظيفة، قُوبلوا بتهم التحريض على تعطيل الإنتاج. وفي كلّ مرّةٍ، يتكلّم فيها المجتمع، تُفضّل الدولة الصمت أو الإنكار على الإصغاء.
خارجياً، ازدادت عزلة تونس. علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية تراجعت، والمفاوضات مع المانحين تعطّلت، فيما ارتفعت نبرة الخطاب السيادي من دون ترجمة في الواقع. أغلقت البلاد على نفسها سياسيّاً، فاقدة القدرة على اجتذاب شركاء أو استثمارات أو حتى تعاطف.
ورغم هذا التدهور، ما زال قيس سعيّد يحتفظ بنواة مؤيدة له، رغم تراجعها الملحوظ، ترى فيه رمزاً للنزاهة الشخصية ورفضاً للفساد القديم. لكنّ الزمن السياسي لا يُقاس بالنيات، بل بالقدرة على الإنجاز. وبعد ستّ سنوات، لم يتحقق وعد “التصحيح”، ولا وُضعت أسس مشروع بديل. ما تحقق هو قبضة أمنية وفراغ سياسي واسع يُدار بخطابات ليلية وقرارات فوقية، في مشهدٍ تتضاءل فيه الدولة وتتعاظم فيه الصورة.
يمكن تلخيص هذه السنوات الستّ في مفارقة واحدة، انتهى الحاكم الذي جاء ليُعيد الدولة إلى الشعب إلى إبعاد الدولة عن الشعب وإحداث شرخ بينهما.