العقل العربي بين حضارتين
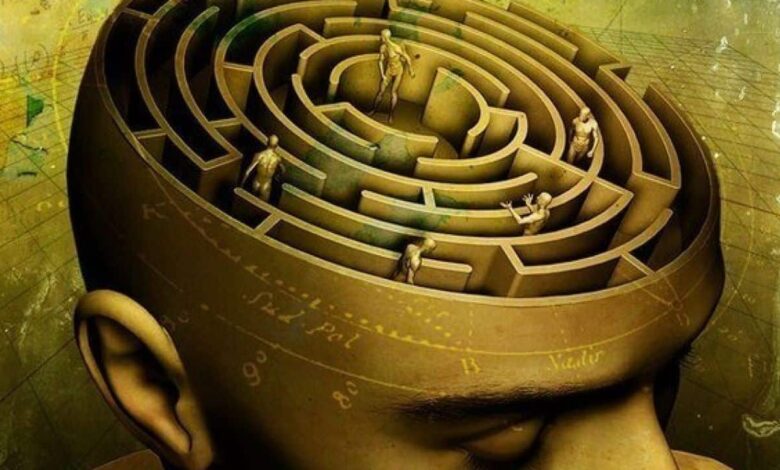
كتب د. خالد أحمد الصالح في صحيفة الراي.
ظلَّ العقل العربي، لعقود طويلة، موضوعاً معقّداً بالنسبة لصنّاع القرار في الغرب والشرق.
فمن ناحية كشف التاريخ حقيقة القدرات التي يملكها العقل العربي المتشبع بالإسلام، تلك القدرات التي صنعت حضارة عظيمة وأخلاقية من الصعب تجاوزها، ومن ناحية أخرى ما فرضته الدولة العثمانية على العرب وخروجهم منها وهم في أسوأ مراحلهم الزمنية حيث فرضت عليهم العزلة والابتعاد عن الثورة الصناعية التي ظهرت في العصر الوسيط وغيّرت موازين القوى.
لقد كانت سحابة الماضي وقلق المستقبل هما الزاد الذي استمدّ منه مثقفو الغرب وفلاسفتها وكتّاب التاريخ فيها عناصرهم الرئيسية لإعطاء صورة سلبية عن العقل العربي والثقافة العربية في محاولة ما زالت مستمرة، في توجيه قادة العالم الغربي إلى الحذر من العقلية العربية ومن أشهر هؤلاء: إرنست رينان (Ernest Renan) –الفرنسي المتوفى عام 1892 الذي ركّز كل جُهده لإقناع العالم بأن الحضارة العربية مجرد ناقلة لحضارات الآخرين، ومنهم هيغل (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) – الألماني المتوفى عام 1831 الذي اعتبر الحضارة العربية مجرد حبل لتوصيل الحضارة الإغريقية بالحضارة الغربية، وأيضاً مونتسكيو (Montesquieu) – الفرنسي المتوفى عام 1755 الذي كشف في كتابه (روح القانون) بالفرنسية (De l›esprit des lois)، كشف عن التمييز العرقي الذي جعل من الشرق عموماً ومنهم العرب مادة للانقاص والتحقير، وهو صاحب نظرية فصل السلطات وقد أثّر كتابه (روح القانون) في الآباء المؤسسين للولايات المتحدة أثناء كتابتهم للدستور الأميركي، وأيضاً فولتير (Voltaire) – الفرنسي المتوفي 1778 والذي بذل جهده للسخرية من الإسلام وهو ربما أول من وصف العرب بالبرابرة، الوصف الذي ظل يشغل عقول قادة غربيين عقوداً طويلة.
ومنهم برنارد لويس (Bernard Lewis) – بريطاني/أميركي المولود عام 1916 والمتوفى عام 2018، وهو مستشرق ومؤرخ معاصر، من أكثر الشخصيات تأثيراً في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط.
وهو من الذين نشر فكره السلبي في عقول قادة الغرب، وأقنعهم أن العالم الإسلامي يعيش أزمة حضارية دائمة ناتجة عن فشل داخلي ثقافي وديني. ومنهم هنري كوربان (Henry Corbin)، فيلسوف ومستشرق فرنسي (1903–1978)، والذي روّج للطائفية والشعوبية والأقليات ومجّدها أمام العقلية الغربية وعلى حساب الأمة العربية ومعتقداتها، وتبدو آثار أفكاره واضحة اليوم في دعم الغرب للطائفية والأقليات لإضعاف العالم العربي وتمزيقه.
ومنهم صموئيل هنتنغتون (Samuel Huntington) – أميركي مولود عام 1927 ومتوفى عام 2008 صاحب كتاب «صدام الحضارات»، والذي اعتبر أن العالم الإسلامي، والعربي خصوصاً، في صدام جوهري مع القيم الغربية، كل هؤلاء وغيرهم كثير من المثقفين والصحافيين والإعلاميين تمت برمجة أدمغتهم على هذه المفاهيم وأصبحت عندهم قناعة تامة راسخة وعميقة بهذه الأفكار والمعتقدات السلبية حول العقل العربي، من هنا كان لزاماً على صناع القرار العربي إدراك تلك البرمجة الدماغية الغربية ومحاولة إعادة صياغتها لتوضيح حقيقة الحضارة العربية الإسلامية القائمة على قيم أخلاقية وسطية تحتاجها البشرية، وتعمل مع بقية الحضارات على حفظ الكائن البشري وتحقيق قيم الفضيلة والعدالة والمساواة، أما القوى الآسيوية الصاعدة
مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، فإن تعاملها مع المنطقة العربية يختلف جذرياً عن تعامل العالم الغربي، وكل من كتب عن الثقافة العربية والإسلامية من الصينيين واليابانيين كانت كتاباتهم محايدة ومنصفة مثل: تشينغ جيان (Qing Juan )، و وانغ يي (Wang – وزير خارجية الصين، واليابانيون أيضاً كتبوا بانصاف وحيادية مثل توشيهيكو إيزوتسو (Toshihiko Izutsu /، ونوبوأكي نوتوهارا (Nobuoaki Notohara)، فالدول الآسيوية لا تستمد أفكارها من خلفيات قديمة سابقة ولا تطرح نفسها كـ «مُخلّص حضاري»، كما أنها لا تتدخل بالشؤون الداخلية لأمة العرب وتركز على الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية، فالصين، على سبيل المثال، تقدم نفسها كشريك لا يُملي شروطاً، لكنها في الوقت نفسه لا تبني علاقة قائمة على الثقة العميقة، بل على المصلحة المتبادلة الباردة.
هؤلاء الزعماء يتعاملون مع العقل العربي كرجل أعمال لا كخطيب سياسي. وهذا، رغم ما فيه من فتور، يحمل نوعاً من الصدق العملي، بعيداً عن الوصاية أو الادعاء الأخلاقي. من هنا كان لزاماً على العقل العربي وقياداته التوازن بين الفكر الغربي والقدرة على إصلاح الخلل في تلك العلاقة التاريخية، وبين العقل الآسيوي المبني على المصالح المشتركة.
في النهاية، نحن اليوم أمام مفترق طرق فإذا لم يتمكن العقل الأميركي بالذات، لم يتمكن من تجاوز آثار الماضي وتمحيص الفكر الأوروبي غير المحايد، فإن العقل العربي عليه أن يبتعد عن التعاون الغربي المبني على سوء النوايا ويعزّز من علاقاته بالحضارات الآسيوية الواعدة.





