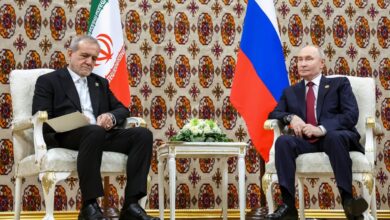مشكلة أميركا أكبر من ترمب وهاريس والحزبين

كتب رفيق خوري في صحيفة إندبندنت عربية.
الرئيس جو بايدن خرج من السباق الرئاسي بنوع من الخيار بالاضطرار، وقادة حزبه الديمقراطي خافوا على حظوظهم من تدني حظه وقدراته، ومن كانوا يقفون وراءه بحماسة طالبوه علناً بالتنحي، ثم أشادوا بزعامته ورئاسته ووطنيته وتضحيته بنفسه من أجل الحزب وأميركا بعدما أعلن بيان التنحي.
أما الرئيس السابق دونالد ترمب الذي خسر أمام بايدن عام 2020 فإن خياره هو الثأر والانتقام بأكثر الوسائل قسوة وشماتة، وأما السيناتور الشاب الأصولي جي دي فانس الذي وصف ترمب عام 2016 بأنه “هتلر الولايات المتحدة” قائلاً “لا يمكنني تحمله ولم ولن أحبه”، فقد عاد لتمجيده ورآه أيقونة عندما اختاره ترمب نائباً له.
ليس من السهل على نائبة الرئيس كامالا هاريس أن توقف صعود ترمب الكاسح، ولا على ترمب أن يأخذ الحزب الديمقراطي إلى القبر، والمشكلة أكبر منهما معاً، ذلك أن المجتمع الأميركي تغيّر والحزب الجمهوري تغيّر والحزب الديمقراطي تغيّر، وأميركا لم تعد أميركا التنافس الديمقراطي الحقيقي في الانتخابات، فحين فاز توماس جيفرسون بالرئاسة قال إن “كل خلاف في الرأي ليس خلافاً على المبادئ، نحن نُدعى بأسماء مختلفة لكننا أخوة في المبدأ نفسه، فكلنا جمهوريون واتحاديون”.
يبدو التنافس اليوم وكأنه معركة بين أعداء لا بين شركاء في الوطن، وأبسط ما رآه أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز، روبرت ليبرمان، هو أن “الاستقطاب السياسي حالياً صار أشبه بالقتال المميت”، فالجمهوريون والديمقراطيون يخوضون المعركة الانتخابية وكأنها حرب وجود، وبايدن اعتبر أن ترمب “خطر على الديمقراطية”، وترمب وصف بايدن الذي قاد على مستوى العالم “تحالف الديمقراطيات” ضد السلطويات الاستبدادية بأنه “خطر على الديمقراطية، والرئيس الأسوأ في تاريخ أميركا”.
والمفارقة أن الرجلين ليسا جديدين بالنسبة إلى الناخبين، ولا لدى أي منهما شيء جديد، فكل منهما قضى ولاية في البيت الأبيض ورأى الأميركيون تجربته واختبروا سياساته، كما أدرك العالم، سواء في صف الحلفاء أو في مرتبة الخصوم لأميركا، حقيقة ما يفعله كل منهما في حروب العالم وسلامه، وفي السعي إلى التنمية والتقدم أو الهيمنة على المقدرات في الجنوب العالمي.
وإذا كان الرئيس السابق باراك أوباما يتحدث عن “تحديات خطرة وصعبة خلال الأيام القليلة المقبلة وإبحار في مياه إلى المجهول”، فالواقع أن أميركا في مأزق ليس من السهل الخروج منه، لا على يدي ترمب و”الجمهوريين”، ولا على يدي هاريس و”الديمقراطيين”.
إنه مأزق يزداد عمقاً بمقدار ما يتصاعد الاستقطاب السياسي، مأزق الفوضى والحرب الأهلية إذا خسر ترمب، ومأزق العداء له إذا عاد للبيت الأبيض، والمأزق في أميركا هو عملياً مأزق في العالم.
إنه مشكلة لحلفاء واشنطن المتخوفين من إستراتيجية الخندقة وسياسة “أميركا أولاً”، كما من إستراتيجية التدخل في كل مكان، من حرب أوكرانيا إلى حرب غزة، ومن المحور في الشرق الأوسط إلى المحور في الشرق الأقصى، ومشكلة لخصومها الذين قد يخسرون عدواً يبقى وجوده ضرورة، إذ لا سياسة لدول كبرى من دون وجود أعداء، وحتى حين حدث عطل في “مايكروسوفت” فإن المطارات والمستشفيات والشركات والقطارات وأشياء كثيرة تعطلت في معظم دول العالم.
وليس في تاريخ الإمبرياليات ما يشبه الإمبريالية الأميركية، فشعوب الإمبرياليات الأوروبية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا كما في الإمبراطورية النمسوية – المجرية كانت متحمسة لغزو العالم، وكذلك الأمر لدى شعوب الإمبرياليات الروسية والعثمانية والصينية، أما في أميركا فإن التناقض هائل بين إمبريالية تنفق سنويا ً850 مليار دولار على الدفاع ولها 800 قاعدة عسكرية حول العالم، وتمارس سياسة إمبريالية في كل مكان، وبين شعب ليس لديه مزاج إمبراطوري.
شعب يتمنى العزلة والالتفات إلى تحسين مستوى العيش، ويخاف من إرسال الأولاد إلى الحروب في بلدان بعيدة، وليس في تاريخ الرئاسات ما يشبه تجربة ترمب، فمن خلال التجربة قال جيفرسون إنه “لا رئيس يحمل معه من الرئاسة السمعة التي حملته إليها”، لكن ترمب هو النموذج المعاكس.
“الملايين الذين اعتنقوا رجل الشعبويين قادوا ترمب إلى البيت الأبيض”، كما قال فرنسيس فوكو ياما، يتحمسون اليوم له ولإعادته للبيت الأبيض وكأنه “تيفلون” لا شيء يعلق عليه، لا الارتكابات ولا المحاكمات ولا الإدانات ولا الفضائح ولا الأكاذيب المضحكة، وما كان ينقصه سوى رصاصة لم تقتله في محاولة اغتيال كي تكتمل معه سياسة الضحية. يوحي أنه ضحية النظام وهو من أصحابه، وكأنه مع الطبقة العاملة وهو المقاول الثري، وكلمتان تختصران سياسته: خوف وغضب.
وإذا لم يحدث أي تطور في اللعبة خلال الأشهر القليلة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن على الأميركيين الاستعداد لمعادلة غير عادية في سياسات ترمب وهي تعميق المشكلة وتبسيط الحل، فليس في العالم الواقعي ما وعد به ترمب حين قال “أنا الوحيد الذي يستطيع وقف أي حرب باتصال هاتفي”، ولا أحد يتصور أن هاتفاً من البيت الأبيض ينهي مشكلة معقدة تهدد بحرب عالمية وهي حرب أوكرانيا، ولا أن “حماس” ستطلق المخطوفين لديها قبل وصول ترمب إلى الرئاسة كما طلب، ولا بالطبع أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيتوقف عن اللعب بالصواريخ والقنابل النووية وتهديد الجيران وإرسال بالونات تحمل النفايات إلى كوريا الجنوبية بمجرد أن يلتقي ترمب، فهذا عالم من الفانتازيا والأوهام.
العالم الواقعي شديد الخطورة، وكل دولة تحبس أنفاسها وتعيد النظر في حساباتها للتعامل مع رئيس مرتقب يصعب التنبؤ بما يمكن أن يفعله. بعد رئيس كلاسيكي من عصر الحرب الباردة لا يستطيع أي رئيس دولة في العالم أن يتوقع ما سيفعله ساكن البيت الأبيض.
أوباما تحدث عن “أزمة معرفية حيث فقد الأميركيون القدرة على التمييز بين الحقيقة والكذبة، وفي مثل هذه الحال تفشل الديمقراطية”، فكيف إذا كانت المسألة أخطر وكانت “الكذبة بالنسبة إلى ترمب ليست كذبة بل ما يفكر فيه، وأنه لا يعرف الفرق بين الكذبة والحقيقة”، كما قال المدير السابق للأمن الوطني دان كوتس؟