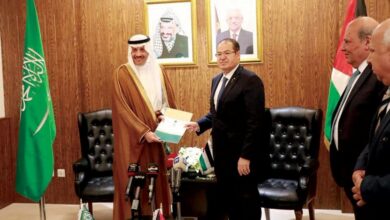شروط الخروج من الانقلاب في تونس

كتب جمال الطاهر, في الجزيرة:
لا يمكن لأي عملية سياسية أن تكون فاعلة وناجعة في ظل منطق الإقصاء والعلاقات الصفرية التي تدار بها الخلافات بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين.
لقد أثبتت التجربة التونسية، منذ الاستقلال وصولا إلى مرحلة ما بعد الثورة ثم الانقلاب، أن الإقصاء ليس فقط خيارا أخلاقيا مرفوضا، بل هو أيضا وصفة مؤكدة للفشل السياسي وعدم الاستقرار.
إن المستقبل السياسي لتونس يمر حتما عبر تفكيك ثقافة الإقصاء وبناء ثقافة سياسية جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل، واحترام الاختلاف باعتباره حقا أصيلا، مع الالتزام بإدارته إدارة ديمقراطية وسلمية.
في هذا السياق، يكتسي الجدل الدائر في تونس خلال الفترة الأخيرة حول إمكانية التوحد ضد الظلم أهمية خاصة، ليس باعتباره مجرد رد فعل ظرفي على الاستبداد، بل بوصفه مدخلا ضروريا لتعميق النقاش حول منطلقات وأسس ثقافة سياسية بديلة تحتاجها البلاد، لا فقط للخروج من نفق الانقلاب، وإنما، وهو الأهم للدخول الفعلي في الحداثة السياسية باعتبارها ثقافة مشتركة بين جميع التونسيين.
التحدي الحقيقي لا يقتصر على إسقاط الاستبداد، بل يتعلق بتغيير قواعد اللعبة السياسية بما يمنع إعادة إنتاج منطق الإقصاء الذي مهد له
من ثقافة الإقصاء إلى ثقافة الاعتراف
يكشف تاريخ الحياة السياسية في تونس، قبل الثورة وبعدها عن هيمنة ثقافة الإقصاء بأشكال مختلفة: إقصاء باسم الدولة الوطنية، ثم إقصاء باسم الحداثة، ثم إقصاء باسم الثورة، وصولا إلى إقصاء باسم “تصحيح المسار”. هذه الثقافة لم تكن حكرا على السلطة فقط، بل شاركت فيها قوى سياسية ومعرفية متعددة، اعتقدت كل منها أنها تحتكر الحقيقة والمصلحة الوطنية.
تقوم ثقافة الإقصاء على منطق العلاقات الصفرية: إما أن أربح بالكامل أو يخسر خصمي بالكامل. وهي ثقافة تعجز بطبيعتها عن إنتاج استقرار سياسي أو بناء مؤسسات ديمقراطية قادرة على الاستمرار.
في المقابل، تقوم الثقافة السياسية الحديثة على مبدأ الاعتراف المتبادل بين المختلفين، والقبول بالتعددية الفكرية والسياسية، وإدارة الخلاف ضمن قواعد متفق عليها سلفا.
يقتضي بناء ثقافة سياسية جديدة في تونس القطع مع منطق التخوين، وشيطنة الخصوم، واحتكار الوطنية، واستبداله بثقافة تعتبر الاختلاف ثروة جماعية لا تهديدا وجوديا، وتتعامل مع السياسة بوصفها مجالا للتنافس السلمي لا ساحة للإقصاء المتبادل.
الجدل حول التوحد ضد الظلم كفرصة تاريخية
ما تشهده تونس اليوم من نقاش عام حول إمكانية التوحد ضد الظلم والاستبداد يمثل فرصة تاريخية نادرة. فالتوحد هنا لا يعني ذوبان الهويات السياسية أو التنازل عن القناعات، بل يعني الاتفاق على حد أدنى من القيم والمبادئ التي لا يمكن بدونها لأي صراع سياسي أن يكون مشروعا أو منتجا.
تكمن الخطورة في اختزال هذا النقاش في بعده التكتيكي، أي في كونه مجرد تحالف ظرفي لإسقاط سلطة قائمة. أما أهميته الحقيقية فتتمثل في كونه مدخلا لإعادة طرح السؤال الجوهري: أي ثقافة سياسية نريد لتونس؟ هل نريد فقط استبدال سلطة بسلطة، أم نريد تغيير قواعد اللعبة السياسية نفسها؟
إذا لم يتحول هذا الجدل إلى نقاش عميق حول أسس العيش المشترك، وطبيعة الدولة، وحدود الصراع السياسي، فإن خطر إعادة إنتاج الاستبداد سيظل قائما، مهما تغيرت الوجوه أو الشعارات.
العائلات السياسية الكبرى كحقيقة اجتماعية
تتكون تونس تاريخيا من مدارس فكرية وسياسية متعددة يمكن إجمالها، دون تبسيط مخل، في ثلاث عائلات سياسية كبرى: العائلة الدستورية، والعائلة الإسلامية، والعائلة اليسارية.
هذه العائلات ليست مجرد تنظيمات حزبية عابرة، بل هي تعبيرات اجتماعية وثقافية عميقة لقطاعات واسعة من المجتمع التونسي، تشكلت عبر التاريخ، وتراكمت حولها منظومات قيم ورؤى للعالم.
لم تنجح يوما محاولات إقصاء أي من هذه العائلات الفكرية والسياسية في إلغائها، بل أدت دائما إلى مزيد من الاحتقان والانقسام، وأضعفت الدولة والمجتمع معا. فالواقع الاجتماعي لا يلغى بالقرارات السياسية، والهوية لا تمحى بالقوانين الاستثنائية.
وقد عبر عدد من الفاعلين السياسيين، في مناسبات مختلفة، عن هذه الحقيقة البنيوية، من بينهم الأستاذ راشد الغنوشي الذي حذر- في ندوة رمضانية لجبهة الخلاص الوطني بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها خلال أبريل/نيسان 2023- من أن محاولة إقصاء أي عائلة فكرية أو سياسية كبرى في تونس ليست فقط وهما سياسيا، بل مغامرة خطيرة تضع البلاد على سكة صراع أهلي؛ لأن الإقصاء في مجتمعات متعددة لا ينتج استقرارا بل يولد عنفا كامنا يهدد وحدة الدولة.
إن الاعتراف المتبادل بين هذه العائلات، بوصفها مكونات شرعية في الفضاء الوطني، ليس خيارا أخلاقيا فحسب، بل شرطا موضوعيا لأي مسار سياسي مستقر.
فلا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية في تونس دون إدماج جميع هذه التعبيرات ضمن قواعد لعبة سياسية عادلة ومتفق عليها، تدار فيها الصراعات سلميا ويُحتكم فيها إلى الآليات الديمقراطية بدل منطق الغلبة.
وقد بينت التجربة التونسية، كما نبه إليه الغنوشي في السياق ذاته، أن البديل عن الاعتراف المتبادل ليس “دولة قوية” كما يروج، بل دولة هشة تعيش على وقع الانقسام الدائم، وتكون مهددة في سلمها الأهلي وفي قدرتها على إدارة الاختلاف داخل المجتمع.
دروس الانتقال الديمقراطي المعطل
أبانت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس عن خلل بنيوي عميق في العلاقة بين مختلف الفاعلين السياسيين. فقد طغت الحسابات الحزبية الضيقة، والنزعات الإقصائية، وصراعات الهوية، على منطق بناء الدولة والمؤسسات. هذا الخلل لم يؤد فقط إلى إرباك المسار الانتقالي، بل ساهم بشكل مباشر في إضعاف التجربة الديمقراطية الناشئة.
لقد قدمت الديمقراطية التونسية، في نهاية المطاف، هدية مجانية للانقلاب، الذي انقض عليها وافتكها أمام أعين الجميع، في ظل غياب جبهة سياسية ومجتمعية واسعة قادرة على الدفاع عنها. والسبب لا يعود فقط إلى قوة الانقلاب، بل أيضا إلى هشاشة الثقافة الديمقراطية لدى جزء كبير من النخب السياسية.
الدرس الأهم من هذه التجربة هو أن الديمقراطية لا تحمى فقط بالنصوص الدستورية أو نتائج صناديق الاقتراع، بل تحمى أساسا بثقافة سياسية تؤمن بالتعددية، وتقبل التداول، وترفض منطق الغلبة.
الحاجة إلى توافق وطني حول ثوابت جامعة
تحتاج تونس اليوم إلى توافق وطني واسع حول جملة من المبادئ والمنطلقات الجامعة، تكون بمثابة ثوابت لا تخضع لميزان القوى السياسي الظرفي، ولا تتغير بتغير نتائج الانتخابات. هذه المبادئ يجب أن تشكل الإطار الناظم للصراع السياسي، وحدوده، وقواعده.
ومن بين هذه الثوابت: رفض الإقصاء، واحترام التعددية الفكرية والسياسية، والالتزام بالديمقراطية كآلية لإدارة الخلاف، وضمان الحقوق والحريات الفردية والجماعية، واستقلال القضاء، وحياد الدولة تجاه الصراعات الأيديولوجية، ورفض توظيف مؤسسات الدولة في الصراع السياسي.
هذه المبادئ لا ينبغي أن تكون مجرد شعارات، بل يجب أن تترجم إلى التزامات واضحة، تشبه في قوتها فصولا دستورية لا يمكن تعديلها إلا بتوافق وطني واسع، لأنها تمس جوهر العقد الاجتماعي، لا مجرد توازنات سياسية عابرة.
تدل ديناميكية الجدل السياسي والفكري الدائر اليوم في تونس على أن الفضاء العام مرشح لإفراز أفكار جديدة وفاعلين جدد، تحرروا إلى حد بعيد من رواسب الحقب السابقة، ومن منطق الاستقطاب الثنائي الذي طبع المرحلة الانتقالية الأولى.
فقد تشكل وعي جيل كامل في سياق عشرية الحريات، واكتسب خبرة سياسية من خلال معايشة تجربة الانتقال الديمقراطي، لا فقط عبر طموحاتها، بل أيضا من خلال إدراك أسباب تعثرها البنيوية، وهو ما يمنحه قابلية أعلى لطرح أسئلة مختلفة حول الدولة، والهوية، والديمقراطية، وحدود الصراع السياسي.
ولا يقتصر هؤلاء الفاعلون على الأطر الشابة داخل الأحزاب السياسية، بل يشملون أيضا فاعلين من خارج المنظومة الحزبية التقليدية، راكموا تجارب مدنية ونقابية وحقوقية وثقافية، واشتغلوا في فضاءات ما فوق حزبية، بما ينسجم مع ما تشير إليه أدبيات الانتقال الديمقراطي من أن لحظات التحول الكبرى لا تنتج فقط نخبا بديلة، بل تعيد تشكيل أنماط الفعل السياسي نفسها.
غير أن هذا التطور النوعي يظل، في المرحلة الراهنة، في بداياته الأولى، ويحتاج إلى زمن سياسي واجتماعي كافٍ لكي تتضح معالمه وتترسخ هويته، وتتحول أفكاره إلى مشاريع قابلة للاستمرار.
فوَفق منطق الانتقال الديمقراطي، لا تسير التحولات في مسار خطي أو تصاعدي ثابت، بل تمر بمراحل مد وجزر، واختبارات وانتكاسات، قبل أن تستقر على توازنات جديدة.
ومن المتوقع أن تواجه هذه الديناميكية مقاومة من البنى القديمة، وضغوطا من السلطة، وصعوبات ذاتية في التنظيم والتنسيق، إلا أن قدرتها على الصمود تبقى قائمة؛ لأنها تعبر عن حاجة حقيقية داخل المجتمع التونسي في سياق مساره التحرري من الاستبداد.
وفي هذا الإطار، لا يمكن النظر إلى هذه التجربة الناشئة باعتبارها قطيعة نهائية مع الماضي أو بديلا جاهزا، بل بوصفها محطة ضمن مسار أطول ومعقد للانتقال نحو الديمقراطية والحداثة السياسية، حيث يتشكل الجديد تدريجيا عبر التعلم الجماعي، وتراكم الخبرات، والتمييز المتزايد بين ما هو مبدأ ومنطلق جامع لا يخضع للتنافس ومنطق الغلبة، وبين ما هو مجال مشروع للتنافس السياسي والانتخابي داخل إطار ديمقراطي مشترك، يدار ديمقراطيا ويظل مفتوحا على التداول والتغيير.
وفي هذا التمييز بالذات يكمن أحد المفاتيح الأساسية لتجاوز أزمات الماضي وبناء أفق سياسي جديد أكثر نضجا واستدامة.
من الخروج من الانقلاب إلى بناء المستقبل
إن الخروج من الانقلاب، على أهميته، لا يمثل سوى خطوة أولى في مسار أعمق يتمثل في بناء حداثة سياسية تونسية قائمة على ثقافة مشتركة لا تقصي أحدا، ولا تدار بمنطق الغلبة، بل تقوم على الاعتراف المتبادل، واحترام التعددية، والتنافس السلمي داخل إطار ديمقراطي جامع.
فالتحدي الحقيقي لا يقتصر على إسقاط الاستبداد، بل يتعلق بتغيير قواعد اللعبة السياسية بما يمنع إعادة إنتاج منطق الإقصاء الذي مهد له.
ويزداد هذا الرهان إلحاحا في ظل بروز ديناميكية جديدة داخل الفضاء العام، مرشحة لإفراز أفكار وفاعلين تشكل وعيهم في سياق الحريات واستفادوا من دروس تعثر الانتقال الديمقراطي، بما يمكنهم من التمييز بين الثوابت الجامعة التي لا تخضع للتنافس، ومجالات الصراع السياسي المشروع.
ورغم أن هذه الديناميكية لا تزال في بداياتها وقد تمر باختبارات صعبة، فإنها تعبر عن حاجة حقيقية داخل المجتمع التونسي في مساره التحرري.
ولن يكون منع عودة الاستبداد ممكنا إلا ببناء ثقافة سياسية بديلة تجعل من الديمقراطية ممارسة يومية، ومن الاختلاف قيمة إيجابية، ومن التوافق حول الثوابت والمنطلقات ضمانة للاستقرار. عندها فقط يمكن لتونس أن تفتح أفقا جديدا يليق بتضحيات شعبها، ويؤسس لدولة حديثة وعادلة وقادرة على الاستمرار.